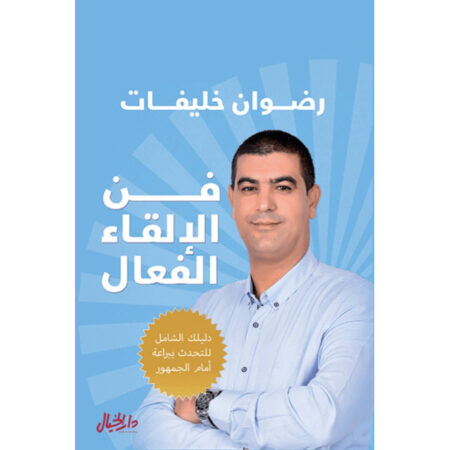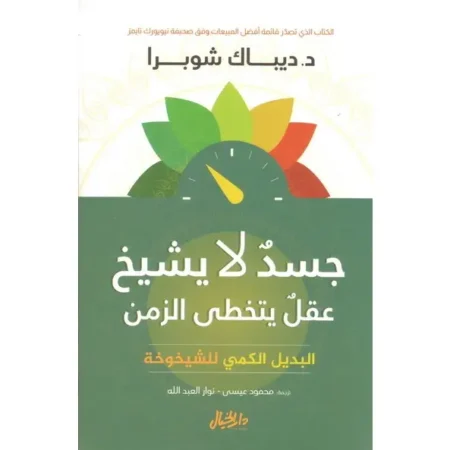-
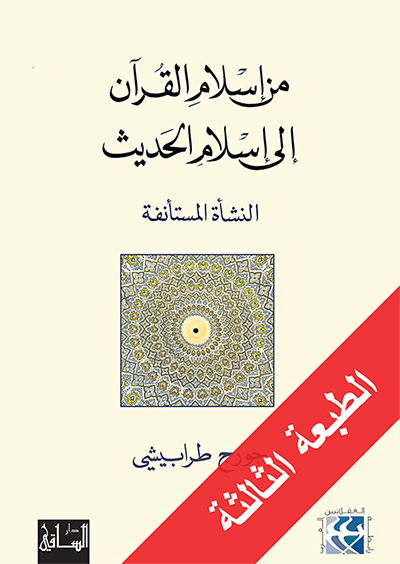
-
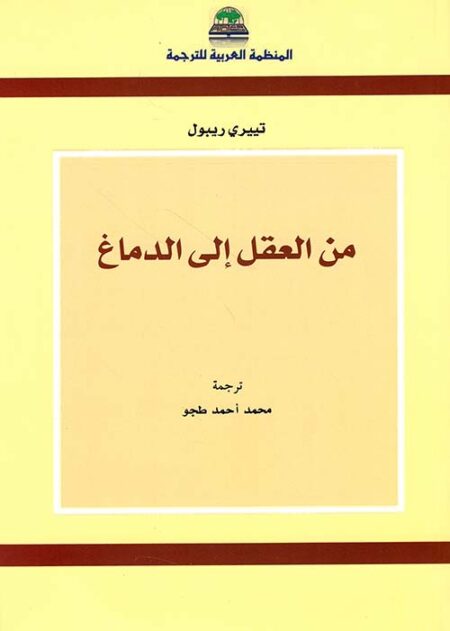
من العقل إلى الدماغ
د.م. 199,00تُقر جميع الثقافات بشكل عام أن عالمنا يتكون من كيانات مادية وغير مادية، والبشر الذين يشاركون في هذا العالم ليسوا استثناء لقاعدة هذا التكوين المزدوج… لأنّ لهم جسداً وروحاً.
يقوم مفهوم الإنسان هذا، وهو وريث تقليدٍ فلسفيّ طويل، بدورٍ مهم في إدراكنا للحياة أو المجتمع أو الإرادة الحرة أو المعاناة النفسية، ويشمل ذلك الذين يقولون إنهم ملحدون أو لا أدريون. ومع ذلك جدّدت ثورة العلوم المعرفية التي شارك فيها علم النفس والعلوم العصبية والذكاء الاصطناعي والفلسفة تجديداً تاماً هذا المفهوم للعلاقة بين العقل والدماغ، وبيّنت أن هذه الثنوية غير موجودة، وأننا لسنا سوى نتيجة نشاطٍ معقد تقوم به مليارات العصبونات.
يحاول تييري ريبول في هذا الكتاب أن يقدّم أكبر عدد من الأدوات لفهم الاضطرابات الفلسفية الناجمة عن علوم العقل، والجدل المعاصر المثير للعاطفة، والاهتمام الذي يترتب على ذلك.
-
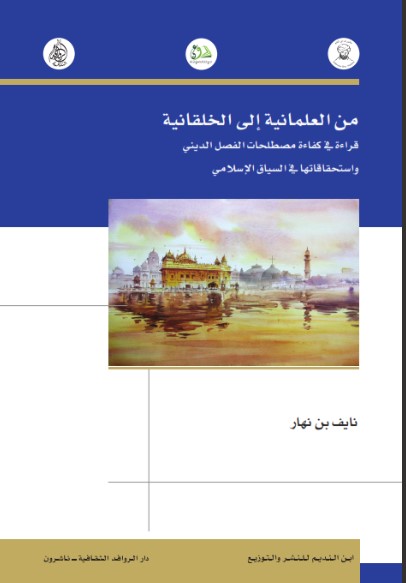
من العلمانية إلى الخلقانية ؛ قراءة في كفاءة مصطلحات الفصل الديني واستحقاقاتها في السياق الإسلامي
د.م. 120,00العلمانية تقوم على ثنائية السلطتين الكنسية والزمنية، ولأنَّ العالم بعد الثورة الفرنسية بدأ رسميًا بفصل السلطتين الزمنية والكنسية حتى لم يعد اليوم هناك أي دولة في العالم تكافح في سبيل الفصل بينهما، فإن مصطلح العلمانية يجب أن ينتهي بانتهاء معطياته، ويصبح جزءًا من التاريخ، فالصراع اليوم لم يعد بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية، وإنما الصراع اليوم بين الإنسان والدين نفسه. فإذا كان صراع السلطة قبل الثورة الفرنسية يقوم على ثنائية العلماني والثيوقراطي، فالصراع اليوم يقوم على ثنائية المتشرّع والخلقاني؛ أي الذي يؤمن بمرجعية الشرع والذي يرفض مرجعية الشرع ويرى مرجعية الخلق بديلاً عنها. وهذا التحوّل في الصراع كان أذانًا في الناس بدخول مرحلة “ما بعد العلمانية”، فأصبحت العلمانية بذلك تعبيرًا عن مرحلة تاريخية انتهت بكل معطياتها، وأصبحنا في مرحلة جديدة يكون طرف الصراع فيها الدين نفسه. واختلاف “أطراف” الصراع يقتضي اختلاف “عنوان” الصراع، ولذلك نقول إنه لا يوجد مسوّغ منطقي لاستعمال مصطلح العلمانية اليوم بعد أن غابت شروطه الموضوعية، وأمسى متعيّنًا أن يحل محله مصطلح “الخلقانية” الذي يعني حرفيًا المطالبة بحصر التشريع في الخلق دون الخالق.
-
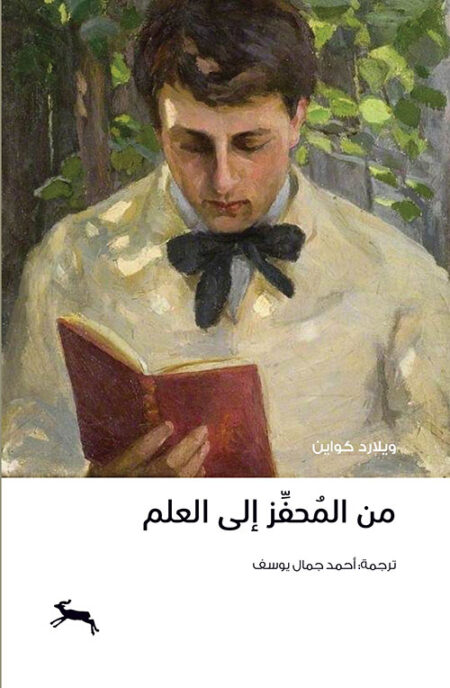
من المحفز إلى العلم
د.م. 119,00ويلارد فان كواين هو أحد أبرز الفلاسفة في القرن العشرين. أصدر كتابًا عميقًا وثريًا يلخص مشروعه الفلسفي بأكمله، بما في ذلك رؤيته لجميع المكونات الأساس لموقفه المعرفي؛ خاصة فيما يتعلق بقيمة المنطق والرياضيات. قد يتعين على القراء الذين يتعرفون على كواين لأول مرة عبر هذا الكتاب أن يقرؤوه ببطء وتأنٍّ، وأن يحاولوا أن يروا بأنفسهم ذلك الثراء والعمق الذي يعرفه عنه القراء السابقون ويكمن بين سطور هذا الكتاب الشيق.أصل هذا الكتاب صغير الحجم محاضرات ألقاها كواين في إسبانيا عام 1990، وفيها شرع كواين بموضعة إسهاماته في سياقها التاريخي. يقدم الكتاب جولة خاطفة في تاريخ الفلسفة (لا سيما تاريخ نظرية المعرفة)، بدءًا من أفلاطون، ثم يصل ذروته المعرفية في رسم مخطط تقديري لمستهدفات كارناب الفلسفية وإنجازاته. يصل هذا بنا إلى الفصل الثاني، الذي يعد مقدمة لمحاولة كواين تطبيع نظرية المعرفة، وهو ما يؤكد سيره على خطى كارناب وتركيزه على المشترك بينهما عوضاً عن الاختلافات. ثم تقوم الفصول التالية بتطوير السرد الطبيعاني لتطور العلم آخذة في الاعتبار إلى أي مدى تحسنت أجهزتنا المفاهيمية حتى نتمكن من رؤية العالم باعتباره يحوي أشياء يمكن إعادة تعريفها. ثم بعد أن أوضَح دور جمل الملاحظة في توفير نقاط الفحص اللازمة لتقييم النظريات العلمية، وبعد أن يئس من بناء معيار تجريبي لتحديد الجمل ذات الدلالة، يتناول كواين في الفصول المتبقية مجموعة متنوعة من القضايا المهمة حول المعرفة، ويختتم بمعالجة موسعة لآرائه في الإحالة والمعنى ومواقفه تجاه المفاهيم النفسية والوسيطة. -
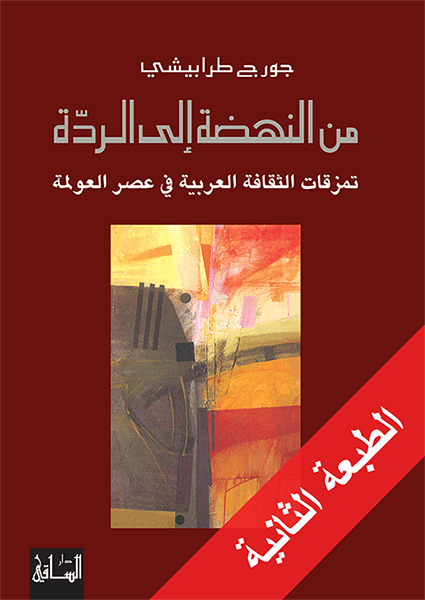
من النهضة إلى الردة تمزقات الثقافة العربية في عصر العولمة
د.م. 99,00هذا الكتاب مسكون بالهاجس النهضوي في زمن طغيان إرادة الردة.من محاور هذا الكتاب: الجرح النرجسي العربي، ثنائية المنافحة والنقد، ثقافة الكراهية، لاهوت نفي الآخر، المرض بالغرب، انطفاء الماركسية، رهاب العولمة، الإسلام والمسألة النسوية، الآخر في التراث العربي الإسلامي، البدعة والعقل المقتول، التراث وأسئلة الحداثة، الهوية والتماهي، الثقافة المنفتحة والثقافة المغلقة، الأسئلة الفلسفية المقموعة، التحديث والتغريب، جدلية الجذور والأجنحة.من حوارات هذا الكتاب: قاسم أمين، طه حسين، زكي الأرسوزي، ياسين الحافظ، نجيب محفوظ، محمد أركون، جلال أحمد أمين، وممثلون آخرون للأنتلجنسيا العربية. -
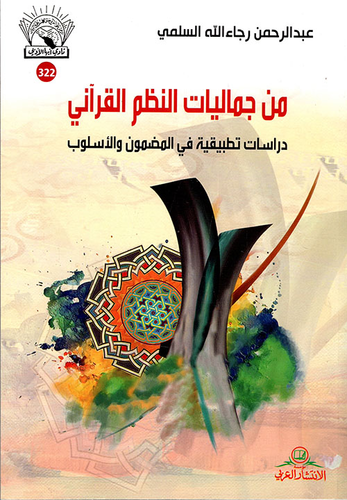
من جماليات النظم القرآني – دراسات تطبيقية في المضمون والأسلوب
د.م. 115,00القرآن الكريم معجز في حقائقه، ومعجز في فصاحته وبيانه وأسلوبه المحكم، ومعجز في أثره النفسي العميق، وبهذا احتل البيان القرآني القيمة الفنية الرفيعة في اللغة العربية، وظلت قضية الإعجاز تقوم في جوهرها على تمثل مناحي النظم الجمالية والإبداعية في ذلك النص المعجز.
ونزول القرآن الكريم بلسان عربي مبين اقتضى أن لا تدرك حقيقته ولا تسبر أغواره إلا من خلال لغته وطرائقه في الأداء البياني.
وجميع الدراسات البلاغية التراثية قد هيأت الأفهام والأذواق لتعدد الدراسات البيانية والأدبية المرتبطة بالنص القرآني في العصر الحديث، إذ لا تجديد في الدراسات البيانية الحديثة إلا على أساس أصيل من قديم موروث يستلهم خير ما فيه ليكون أساساً راسخاً لجديد اليوم، آخذاً في أصوله المنهجية خصوصية هذا النص المقدس ومصدره الرباني.
ولا شك أنّ للأساليب البلاغية أهمية كبيرة في تقريب فهم النّص القرآني الكريم ودوراً بارزاً في إستكناه دلالاته المضمونية والتعبيرية… ولهذا سعت هذه الدراسة في فصولها المتنوعة إلى تتبع أسرار بلاغته والكشف عما يتميز به أسلوبه من ثراء معرفي وخصائص بيانية.
-
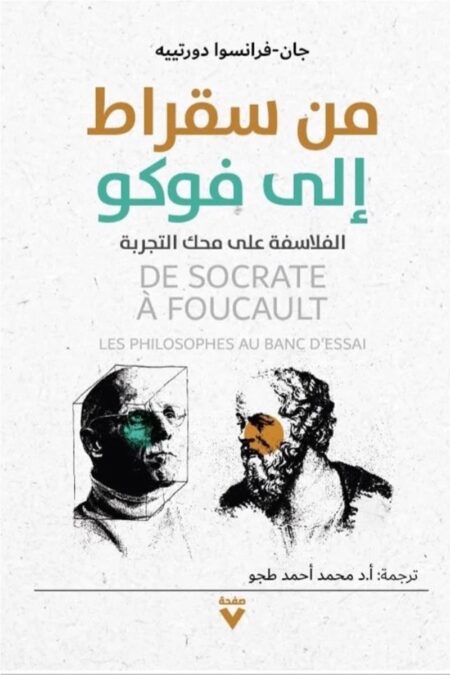
من سقراط إلى فوكو ؛ الفلاسفة على محك التجربة
د.م. 120,00ما الفلسفة حقا؟ هل نعيش بشكل أفضل حين نتوسل بها؟ هل يتطور تفكيرنا؟ وهل تمكننا من إدراك المعرفة والحقائق إدراكا أعلى كما يعتقد أفلاطون وسبينوزا أو هيجل؟ ألا تكون مجرد طريقة “لإدارة العقل بشكل جيد” (ديكارت)، أو لتوضيح أفكار المرء (فيتغنشتاين) أو حتى لإنشاء عِلْمٍ جديد للعقل (هوسرل)؟ ألا يمكن أن تتحول إلى آلة شيطانية، لا تُنتج أي معرفة، لأنها ببساطة تريد دائما التشكيك في كل شيء؟
يسعى هذا الكتاب إلى فهم المشروع الفلسفي وطبيعته وطموحاته، عبر تحقيق دقيق لخمس عشرة شخصية فلسفية عظيمة، من سقراط إلى ميشيل فوكو، محاولا الوقوف على المشروع التأسيسي الذي غذّى تفكير الجميع، وإعادته إلى زمانه وسيافه و«حدسه التأسيسي»، ولكن دون إخفاء مناطقه الرمادية وتناقضه وطرقه المسدودة. ومن هذه الزاوية فهو يطمح إلى وضع مناهج هؤلاء الفلاسفة وأدواتهم على «محك التجربة». فما الذي تجلبه لنا قراءة أفلاطون أو أرسطو أو كانط أو سبينوزا أو دريدا فعلا؟ وكيف كان مآل الفلسفة التحليلية والظواهر وفلسفة العلم بعد قرن من ظهورها؟
في هذا الكتاب، يُخرج جان فرانسوا دورتييه خمسة عشر وحشا مقدسًا من قفص الطمأنينة ويضعهم تحت مجهر العقل، وهو يطرح عليهم وعلى القارئ سؤالا محوريا: هل يجعلنا الفلاسفة حقا أكثر ذكاء؟
-
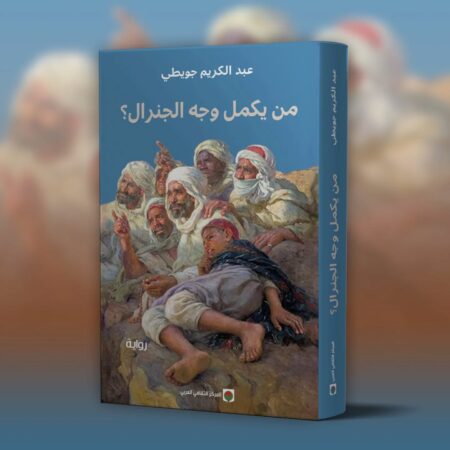
من يكمل وجه الجنرال؟
د.م. 150,00رواية عظيمة و استثنائية، لا تخرج منها أبداً كما دخلتها، رواية تدفع للتفكير في كل ما عرفناه…
-
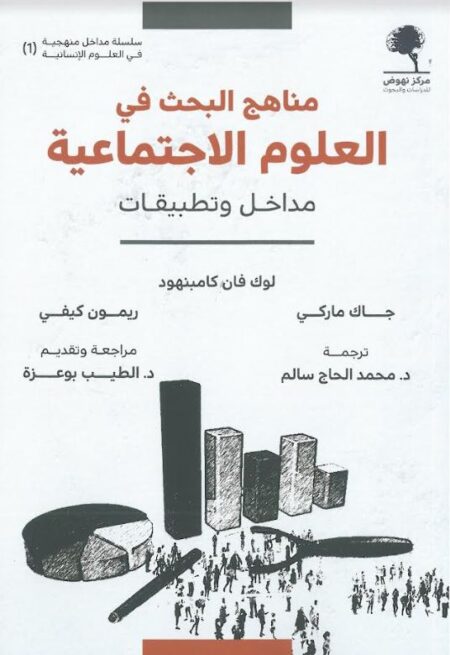
Alif Baa Alkitab Librairie Papeterie – El Khayati