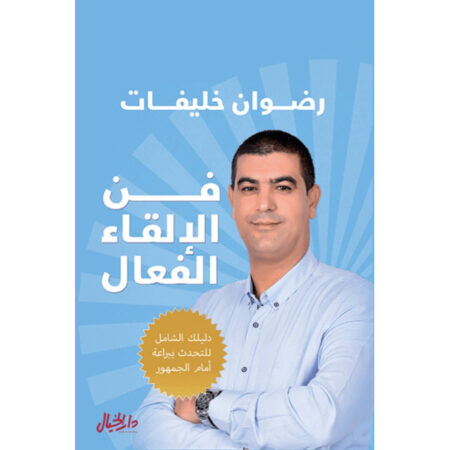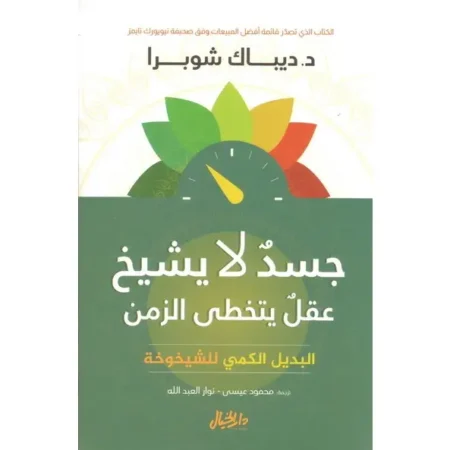-
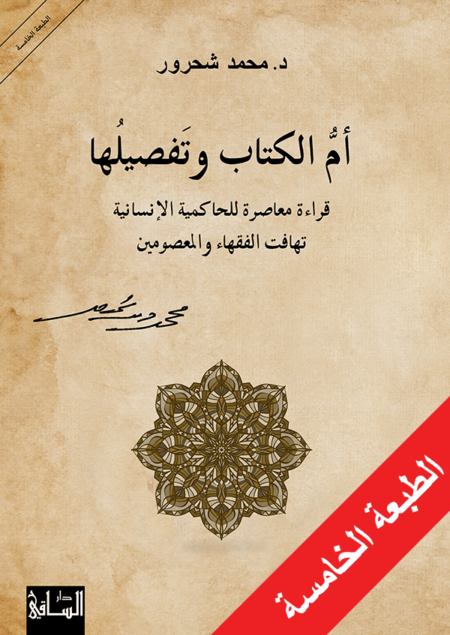
أمُّ الكتاب وتفصيلها قراءة معاصرة للحاكمية الإنسانية، تهافت الفقهاء والمعصومين
د.م. 185,00يتابع الدكتور محمد شحرور في كتابه هذا قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم، وذلك من خلال تطبيق منهجه على موضوع المحكم والمتشابه، متتبّعاً المفاهيم التي تحملها هذه الآيات حول هذين المصطلحين، وما يرتبط بهما من مواضيع ذات علاقة كالتأويل والاجتهاد.يقدّم المؤلّف دراسة معاصرة لعملية الاجتهاد في نصوص التنزيل الحكيم، انطلاقاً من نسخ كل الاجتهادات الإنسانية السابقة في تفصيل المحكم من هذه النصوص، وإعادة الاجتهاد فيه بروح معاصرة، بعيداً عن القراءة التراثية الأحادية الملزمة وراثياً. تلك القراءة التي أوقفت التاريخ وصيرورته عند لحظة معينة، ما جعل الثقافة العربية الإسلامية هشة ضعيفة يستحيل صمودها أمام ثقافات الدول الأخرى المتطورة إلا بممارسة العنف، من خلال قطع الرؤوس والرجم والجلد، لإثبات وجودها -

-
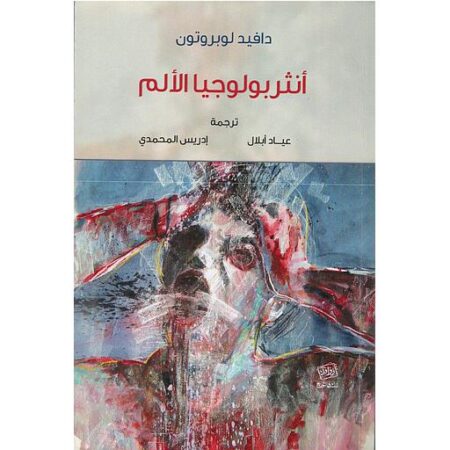
-
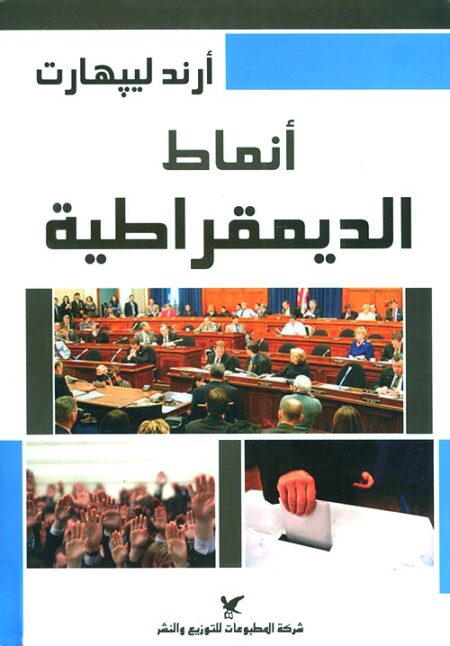
أنماط الديمقراطية
د.م. 165,00يتناول ليپهارت بالتحليل العميق والتفاصيل الدقيقة ستاً وثلاثين ديمقراطية في العالم أجمع، على مدى نصف قرنٍ يمتدّ من العام 1945 إلى العام 1996، مغيّراً النظرة السائدة إلى الديمقراطية وأنواعها بالأدلّة التي يقيمها والأوضاع التي ينقل صوراً عنها من دولٍ اعتمدت واحداً من أنواع الديمقراطية.
يصل ليپهارت إلى خلاصة مهمة – وغير متوقعة – حول أي نوع من الديمقراطيات أجدى. ففي حين أن المتفق عليه هو تفوّق الديمقراطيات المعتمدة مبدأ الأكثرية، مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، على الأنظمة التوافقية مثل تلك الموجودة في سويسرا مثلاً، يظهر ليپهارت أن الأمر ليس كذلك، معتبراً أن الأنظمة التوافقية في الواقع تحفّز النمو الاقتصادي، والسيطرة على التضخم والبطالة، وتحدّ من العجز في الميزانية، مثلها مثل الديمقراطيات المعتمدة مبدأ الأكثرية. والديمقراطيات التوافقية تتفوّق بوضوحٍ على النظام الأكثري من حيث المساواة السياسية، وتمثيل المرأة، والتقارب بين مصالح الناخبين وسياسات الحكومة. يثبت الكاتب، وهو يقارن بمنهجية بين اللجان الاستشارية، والتشريعية، والأحزاب، والأنظمة الانتخابية، والمحاكم العليا، ولأول مرة، الجماعات ذات المصالح، والبنوك المركزية، أن الديمقراطية كلّما كانت أكثر توافقية، كانت “أكثر لطفًا” بتناولها مواضيع الرعاية الاجتماعية، والعدالة البيئية والجنائية، وقضايا المساعدات الخارجية.
-
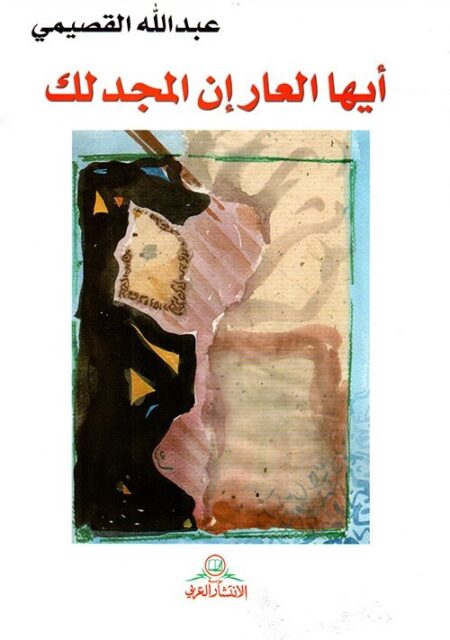
أيها العار إن المجد لك
د.م. 170,00عبد الله القصيمي من خلال جملة هذه المقالات أو النصوص أو المقاطع الكلامية، يصرخ ويحتج ويقول كل ما يعتلج في صدره في جميع حالاته حتى في حالة الجنون الفكري في محاولة لسيتمع إلى صوت ذاته وليسمعه ليعرفه من بين أصوات السماء وأصوات المنابر والمحاريب، وأصوات السوق والتاريخ، وأصوات الرهبة والإرهاب، وأصوات البداوة: بداوة التاريخ وبداوة المواهب، ويسأل الآخر: هل لك صوت؟ هل لأي شيء صوت؟ هل أنت صوتك أم أنت الأصوات الأخرى؟ وهل يوجد من يستطيع أن يجد ذاته أو أن يعرفها أو أن يعيشها بين كل هذه المقابر والأشباح والذوات، إن صوت وذات كل إنسان ضائعان ومهزومان ومتلاشيان في الأصوات والذوات الهائلة التي تحاصرهما وتحكمهما وتضللهما، في كل الأوقات من كل الآفاق بكل الأساليب واللغات وبكل الأسلحة. عربي يريد أن يكون كل ذلك… إذن هل يوجد أشد غربة أو شذوذاً منه؟.. وفي تفسير هل يوجد أشد ضعفاً وضياعاً منه؟ أجل، هل يوجد أشد اغتراباً أو شذوذاً أو ضعفاً وهزيمة من عربي يعيش في العالم العربي ويريد أن يكون ذاته فقط وصوته فقط ذاك ما يراه القصيبي ولتلك الأسباب سطر كلماتها في “أيها العار إن المجد لك”.
-
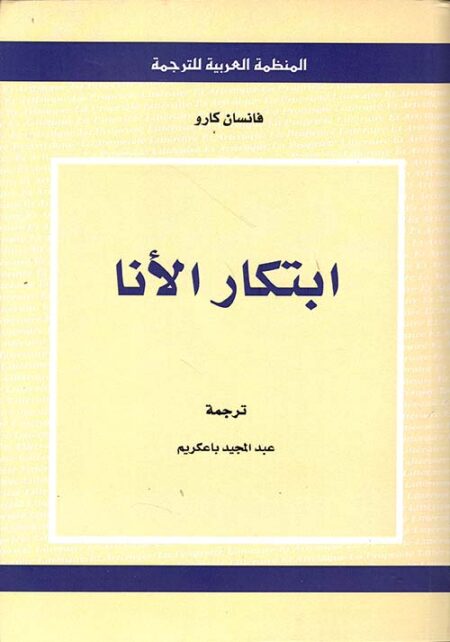
-
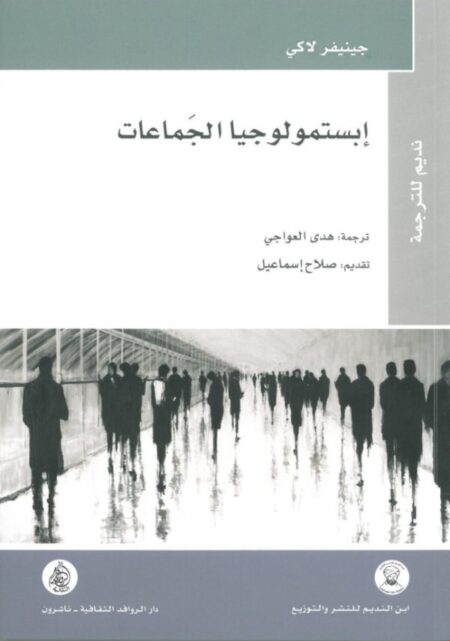
إبستمولوجيا الجماعات
د.م. 150,00شنت الولايات المتحدة الأمريكية حرباً على العراق عام 2003 بدعوى أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، ثم تبين للعالم عدم صحة هذه الدعوى، وقال الناس: لقد كذبت الإدارة الأمريكية.كانت نظرية المعرفة (الإبستمولوجيا) التقليدية تنسب المعرفة إلى الذات العارفة الفردية، وتركز على الفاعلين الأفراد وحالاتهم الاعتقادية، مثل “يعتقد زيد بقضية معينة”. أما أن ننسب الحالات المعرفية إلى الجماعات، مثل “كذبت الإدارة الأمريكية”، فهذا تحول في الإبستمولوجيا إلى الفاعل الجماعي.
إبستمولوجيا الجماعات حقل فرعي حديث من الإبستمولوجيا الاجتماعية، ظهر بصورة واضحة مع مطلع القرن الحادي والعشرين، فعقدت له المؤتمرات وكرت له الأعداد في المجلات الأكاديمية. يعني ببحث الخصائص والمفاهيم المعرفية للجماعات، ويمتاز بأهمية بالغة على المستويين النظري والعملي على حد سواء، فهو يمكن من فهم ماهية الجماعة وملامحها المعرفية، وأفعالها – كالتقرير والكذب، ثم ما إذا كانت مسؤولية تلك الأفعال تقع -قانونية وأخلاقياً- عليها بصفتها كائنا واحدا، أم على أعضائها الأفراد، أم على الطرفين معا. ثم بيان تلك العلاقة الدقيقة التي تربط الجماعات بمتحدثيها الرسميين، حين تمنحهم سلطة التحدث والفعل باسمها. تقدم جينيفر لاكي في هذا الكتاب الثري – أستاذة الفلسفة في جامعة نورث وسترن- خلاصة أعوام قضتها بحثاً عن أسئلة ظلت غائبة إلى حد كبير عن الدراسات الإبستمولوجية السابقة، وبذلك فإن هذا الكتاب يضع حجر الأساس في نطاق واسع من الموضوعات، ويشق الطريق لمزيد من التنقيب والنظر.
جينيفر لاكي: أستاذة الفلسفة بجامعة نورث وسترن ومن أبرز الفلاسفة المختصين في الإبستمولوجيا الاجتماعية عالمياً، تشغل رئاسة التحرير بمجلة Episteme الرائدة والتحرير بمجلة Philosophical Studies المُحكّمتَين، حازَت عام 2015 على جائزة Dr. Martin R. Lebowitz and Eve Lewellis Lebowitz الفلسفية. نشرَت عشرات الأوراق البحثيّة وحرّرَت عدة كتب ومن مؤلفاتها كتاب «التعلم من الكلمات: الشهادة بوصفها مصدراً للمعرفة» عن دار جامعة أكسفورد (2008). -
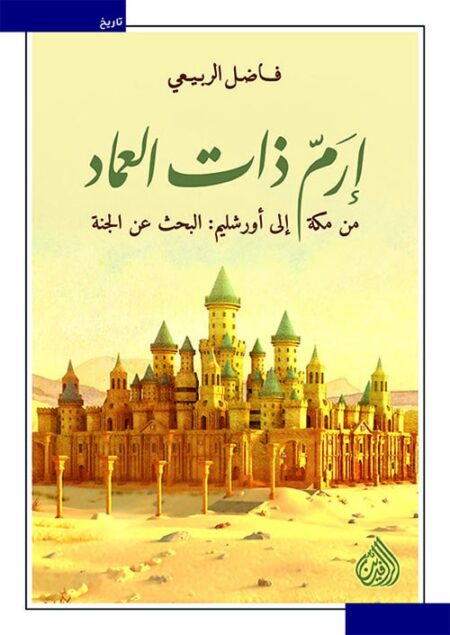
إرم ذات العماد ؛ من مكة إلى أورشليم : البحث عن الجنة
د.م. 120,00قد يكون البحث عن الحقائق التاريخية والأساطير المفقودة شغفًا لبعض الناس، والآن بعد قراءة كتاب “إرم ذات العماد” من تأليف فاضل الربيعي، أصبح هذا الشغف ينمو بشكل أكبر. يستعرض هذا الكتاب التاريخ والأساطير حول مدينة إرم، التي تم ذكرها العديد من المرات في القرآن الكريم ولم يتم العثور عليها بعد. من خلال رحلة شيقة ومثيرة، يسافر القارئ إلى عالم الأساطير والتاريخ للتحقق من وجود إرم، وليتعلم المزيد عن هذه المدينة المفترضة. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن إرم، هذا الكتاب هو الأفضل للاستمتاع بقراءة مثيرة وتعرف على ثقافة جديدة.
كتاب إرم ذات العماد من مكة إلى أورشليم: البحث عن الجنة هو عمل مستند إلى حقيقة تاريخية وموروثية تدور حول مدينة إرم الأسطورية. يقوم المؤلف، فاضل الربيعي، بالبحث عن كل جانب من جوانب تاريخ هذه المدينة، ويستند إلى المعتقدات والثقافة القديمة والتي عاشها مجتمع العرب قبل الإسلام.
يتناول الكتاب “إرم ذات العماد” للكاتب فاضل الربيعي التاريخ الموجود حول مدينة إرم والأساطير المتداولة بهذا الصدد. ويحذر الكاتب من التعامل مع هذه الأساطير على أنها خرافات بلا أساس، وإنما يشجعنا على استخدامها كمرآة لثقافة متوارثة ولتحليل تلك الحقائق التاريخية المتوفرة. كما يسعى الكاتب في الكتاب إلى إيضاح حدود الفروق بين التاريخ والأسطورة فيما يتعلق باسم إرم ومدينته
-
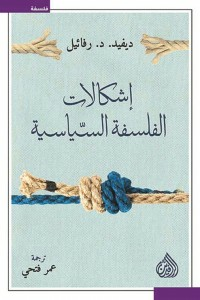
إشكالات الفلسفة السياسية
د.م. 95,00يهدف هذا الكتاب إلى تعريف القراء على مسائل (وليس تاريخ) الفلسفة السياسية دون افتراض وجود أي معرفة سابقة بالفلسفة.ويعد مرجعاً أساسياً هاماً لكل مهتم بالشأن السياسي، إذ يستعرض بلغة علمية سلسة، تعريف فلسفة السياسة ومفاهيم الحرية والسلطة، ونظريات العدالة والديموقراطية، موضحاً العلاقة بين السياسة والدولة وخصائص أي دولة قوية ومتميزة، ومستعرضاً دور الجماعات والجمعيات وأنماط القواعد التنظيمية، بالإضافة لمناقشة دور الحريات وحدود الدولة فيها ليختتم الكتاب بفصلين ممتازين عن فلسفة السلطة والسيادة وأسس الالتزام السياسي ونظرياته.إنه كتاب لا غنى عنه لفهم لعبة السياسة وأسرار مطبخها الداخلي، وسترى بعد إتمام الكتاب أنك مجهز بعدة معرفية كافية لمواجهة وتحليل القضايا السياسية التي تواجهك.
Alif Baa Alkitab Librairie Papeterie – El Khayati