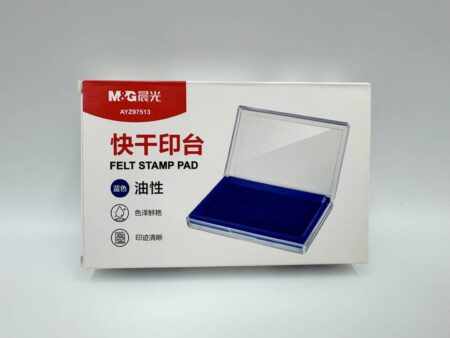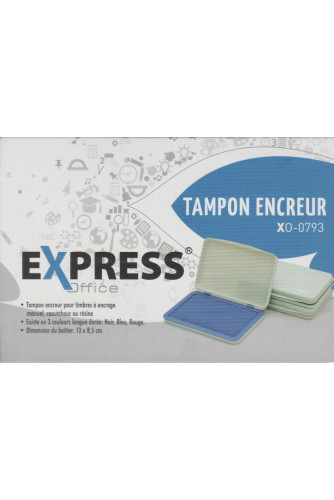-
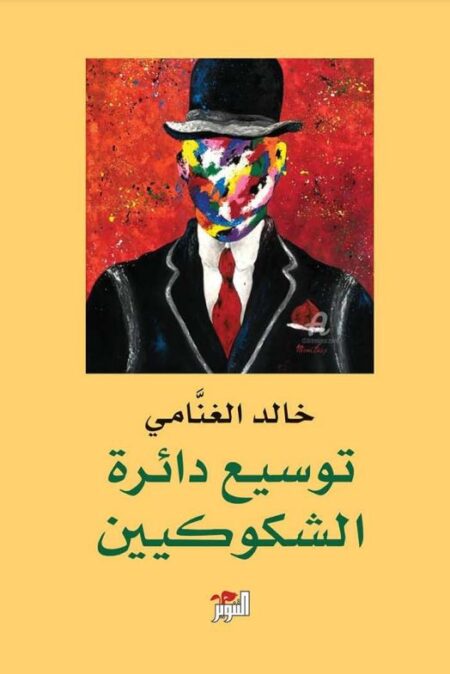
توسيع دائرة الشكوكيين
د.م. 120,00الشكوكية، من أبرز التيارات الفلسفية، تيار ترافق ظهوره مع ظهور الفلسفة باعتباره تيارًا معارضًا لكل يقين، ولكل حقيقة ثابتة ناجزة، وهي المهمة الأولى للتفكير الفلسفي. بل يمكن القول إن الشكوكية كانت مدرسة تنويرية معارضة لأي هيمنة فكرية، وهذا ظهر بوضوح مع عصر النهضة الذي استند بقوة على الشكوكية، أو ما يسمى «البيرونية الجديدة»، فكان لإعادة اكتشاف نصوص أمبريكوس أثر كبير في التحولات الفكرية والفلسفية التي امتدت إلى العصر الحديث.
في سياق سردي تاريخي، يتناول هذا الكتاب الشكوكية في ثلاث حقبات مختلفة، ليس فقط من أجل تعقّب تطور تلك المدرسة التي كان لها تأثير قوي ابتداءً من الحقبة الإغريقية مرورًا بالعصر الوسيط وعصر التنوير حتى يومنا هذا؛ بل، وقبل أي شيء آخر، من أجل تقديم المعنى الحقيقي للشكوكية وأهميتها في إنهاء حركة الجمود والظلامية.
على الرغم من الاتهامات التي وُجّهت للشكوكيين، والحُكْم عليهم كلهم بأنهم أهل الجدل بالباطل وحصر مفردة «سفسطة» بمن ينكر «الحقائق المطلقة»، فإن الشكوكية ليست جعجعة شخص يجب إخراسه، وليست مجرد سلسلة من الشكوك المتعلقة بالمعتقدات الدينية، بل هي فلسفة تشمل كل مجالات الحياة. فالشك ضرورة لحركة الفكر وشرط للتطور، وما كان الترقِّي ليحدث لولا أولئك الفلاسفة الذين واجهوا الدوغمائية وهيمنة الحقيقة الواحدة… لذا، لا بد أن يكون الشكّ حاضرًا على الدوام للتصحيح والكشف عن مواطن الزيف… إنه السبيل لهدم كل ما هو ثابت
-
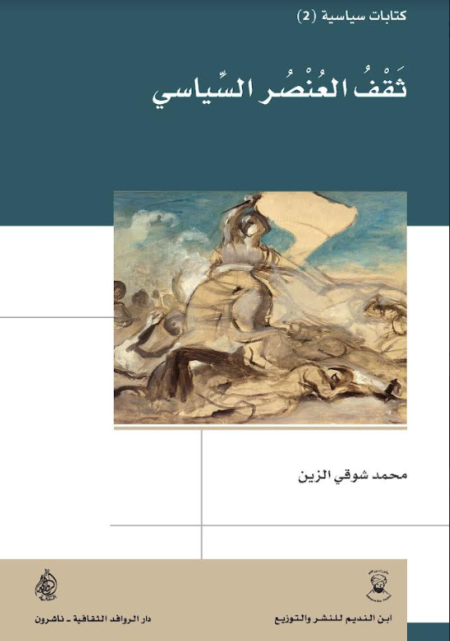
ثقف العنصر السياسي كتابات سياس1&2
د.م. 9.786.144.662.113,00كانت مقدّمة «كتابات سياسية 1» موجَّهة خصّيصًا لفهم طبيعة الفعل البشري بناءً على نموذجي ماكيافيلي والعتائقي بالإشارة إلى جدل الحظ والموهبة، ودور الحيلة في تعقُّل الأشياء وإدارة العمليَّات، وتجليَّات ذلك في المباحث المدروسة في ثمانية فصول. يتبيَّن بأنَّ ما أشرنا إليه هناك يخصُّ «ثَقْف» اللحظة الوجودية في الموقف من العالم، و«ثَقْف» اللحظة السياسية في إدارة الشؤون. وهذا بالضَّبط ما تعمل «كتابات سياسية 2» على إبرازه في هذا الكتاب بفصوله التّسعة، لكن بالتَّوكيد على المخيال السياسي أو الكيفية التي يُدرَك فيها الفعل السياسي، ليس بناءً على سلوكيات ووظائف فحسب، بل وأيضًا باللُّجوء إلى مواقف، وذاكرات، وبطولات، ومثالات عُليا. يحمل عنوان الكتاب الأوَّل كلمة «ثِقَاف» (السياسة والأخلاق)، ويحمل هذا الكتاب الثَّاني كلمة «ثَقْف» (العُنصر السياسي)، وليس بين الكلمتين من تعارض، وإنَّما تشتغلان بالموازاة وفي تضايف تام. كل «ثِقَافٍ» كإجراء ثابت واستراتيجي ومُثقل بالإكراهات والضَّوابط والقواعد إنَّما يُقابله (معجميًا)، ويعتمل فيه (فعليًا) «ثَقْفٌ» كإجراء متحوّل وتكتيكي، وفارّ وغير مستقرّ، وطارئ ومباغت، يُحرّكه ويُليّن من خشونته. إنَّ حقل الإمكانات الذي ترتع فيه السياسة هو مجال «الثَّقْف» بامتياز، مع بقاء الحقل نفسه، بقواعده ووسائله، وبرواسخه القاعدية ورواسبه التَّاريخية والتُّراثية، «الثِّقَاف» الذي ينعتُ «الإطار أو الحلبة». -
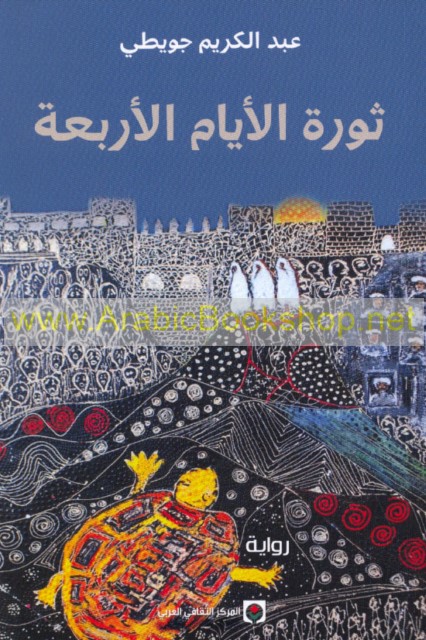
ثورة الأيام الأربعة
د.م. 120,00ولأن الشبّان في الوادي يخرجون ولا يعودون، ولأن الوادي القاسي لم يعد يقنع أحداً بالبقاء فيه، ولأن رغبات وحاجات جديدة وُلدت ولا يمكن إشباعها إلّا في مكان آخر، فقد انضافت تباعاً للربوة نساء أخريات كان لهنّ غائب أو شيء ما لينتظرنه، سعد، زوج، صحّة، أمان…
وبتلك الطاقة الروحية التي تسكن أمكنة بسيطة ومتواضعة لا تهب ما هو خارق وإستثنائي، وإنما تعطي وبسخاء ذلك الجوهر الذي لا تستقيم حياة القهر إلّا به: الرجاء.
صارت الربوة رديفة للأمل، ولِما سيأتي على حين غرة، ولذلك الخيال الذي يتقدّم، وفي كل خطوة يقترب بها يبدِّد غمة ويدوس خصاصة وينهي دمعاً، عشرون عاماً بأيام زمهريرها وثلجها ومطرها ورعودها وأيام حرّها ورياح شركها الخانقة، وهنّ هناك كل يوم مترقِّبات متلهِّفات يتطلّعن لما سيلده المدخلان، وما مات من مات خارج الوادي إلّا لأن لا قلب في الربوة ينتظره ويهفو لظهوره، وما غاب من غاب إلّا لأن لا عين في الربوة تتشوّق لرؤيته قادماً، وما وُلد شيء في الوادي أقوى من أمل الآتي، وصمود النساء في ترقبه
-

-
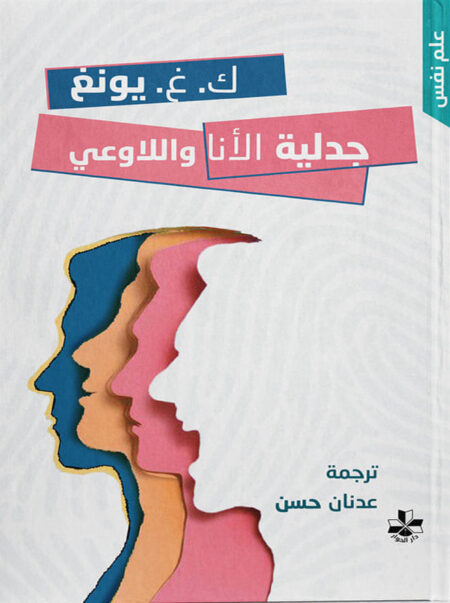
جدلية الأنا واللاوعي
د.م. 100,00يدرس يونغ في هذا الكتاب التفرد وتأثيرات اللاوعي في الوعي. ومن أجل ذلك بحث فيما بين اللاوعي الفردي واللاوعي الجماعي, وفي نتائج تمثل اللاوعي, والعنصر المكون للنفس الجماعية, ومحاولة استخراج وتحرير الفردية من النفس الجماعية. كما بحث في وظيفة اللاوعي. وفي تقنيات وتمايز الأنا عن صور اللاوعي. ولأن الفلسفة الشرقية تهتم بالصيرورات الضمن نفسية منذ قرون, فإن المؤلف يقترح متابعة دراسته لشخصية المانا في هذا الكتاب عبر كتابه الآخر سر الزهرة الذهبية. من المحتويات: في تأثيرات اللاوعي على الوعي, اللاوعي الفردي واللاوعي الجماعي, نتائج تمثل اللاوعي, القناع, محاولات استخراج وتحرير الفردية من النفس الجماعية, التفرد, وظيفة اللاوعي, الأنيما والأنيموس, الشخصية المانا. -
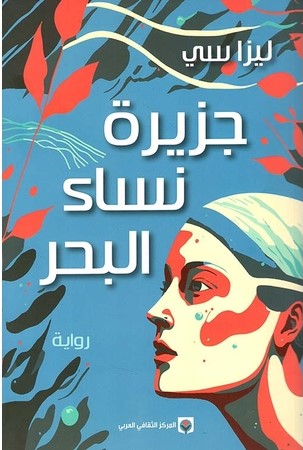
جزيرة نساء البحر
د.م. 130,00لقد فعلوا هذا بي. لقد فعلوا ذلك بي”. المرأة التي تفكر بهذه الطريقة لن تتغلب على غضبها أبداً. أنتِ لا تعاقَبين على غضبك. أنتِ تعاقَبين بغضبك”.
أصغيتُ لها، لكنها لم تخبرني بشيءٍ لم أكن أعرفه بالفعل، إذ كنتُ بالطبع أعاقَب بغضبي. لقد عشتُ مع ذلك كل يوم”.
تأخذنا رواية جزيرة نساء البحر إلى عالم الهينيو، هؤلاء الغواصات الجسورات، وتزرعنا في قلب الأحداث الزاخمة التي شكَّلت حياتهنّ على جزيرة جيجو الكورية.
ومن خلال قلبَي مي-جا ويونغ-سوك ـ فتاتان صغيرتان تنضجان لتصبحا امرأتين لكلٍّ منهما عائلتها الخاصة ـ وعيونهما وتجاربهما، نكتشف ثقافةً فريدة لا تنسى؛ ثقافة حيث النساء في موقع المسؤولية، ومنخرطات في أعمال خطيرة وذات طابع بدني، في حين أن الرجال هم الذين يعتنون بالأطفال. فننخرط في قصصهنّ، ونتشارك أسرارهنّ الدفينة، ونعيش صداقاتهنّ وأحلامهنّ، ونسبر أغوار جراحهنّ ومشقّاتهنّ، ونستمدُّ الإلهام من قدرتهنّ المذهلة على دفع أنفسهنّ مرّةً بعد مرة من الأعماق صعوداً إلى السطح.
خذوا نفساً عميقاً، وغوصوا في أسلوب ليزا سي الآسر، توغّلوا عميقاً في هذه الرواية الساحرة التي ستستحوذ عليكم بالكامل؛ روايةٌ ستحتلُّ مكانها في قلوبكم إلى الأبد -
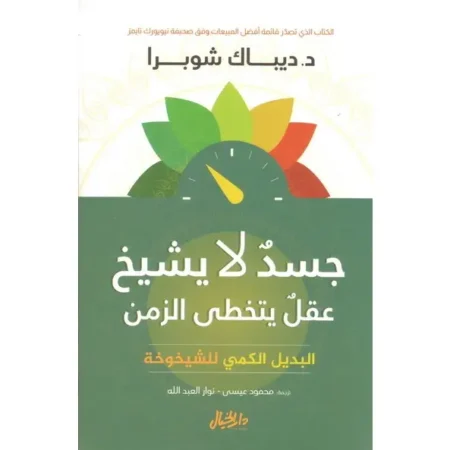
-

جمهورية أفلاطون المدينة الفاضلة
د.م. 120,00في فترة البؤس، الّتي تلت حروب البلوبونيز، وفي السنة الّتي مات فيها بيركليس، عام (429 ق. م)، ولد أفلاطون في أسرة نبيلة، وتربّى تربية أمثاله من أبناء النبلاء، ومن الغريب أنّه لم ينهج نهج أقرانه الشرفاء في الحياة، فلم تجذبه الحياة السياسيّة بسلطاتها وجبروتها، ولم تخدعه ظواهر الإرستقراطيّة والألقاب وغيرها مّما يتطلّع إليه الشبّان عموماً وأبناء الطبقة العالية خاصّةً؛ فلقد احتقر كلّ ذلك واطمأنّ إلى العزلة الفلسفيّة، ولما بلغ العشرين صحب سقراط، وتولّد بينهما ما يتولّد عادةً بين الفتى المجتهد والمعلم العظيم، وقد تأثر أفلاطون بسقراط، ليس فقط في آرائه ومعتقداته، بل في حياته وأخلاقه، ولا يخفى أنّ سقراط كان مثالاً طيّباً للرجل قويّ الإرادة، القادر على كبح أهوائه، المتّبع في الحياة آراءً وقواعد لا يحيد عنها ولو تجزّع السمّ القاتل.
وبعد موت سقراط، قام أفلاطون بعدّة رحلات زار فيها ميغاريا ومصر وغيرها، وقد أفادته هذه الرحلات فوائد جمّة، ففضلاً عن أنها أكسبته خبرة بالناس والأخلاق، وعادت على نفسه بالمتعة واللذّة، فإنّها هيّأت له فرصة التعرّف على الفلسفات القديمة والحديثة، كالفيثاغوريّة والميغاريّة وغيرهما، مما كان له أكبر الأثر في حياته الفلسفيّة، وعاد أخيراً إلى أثينا وهو في الأربعين، حيث التف حوله طلبته، وأخذ يلقي دروسه في الأكاديميّة، وخيّم السكون والتفكير على حياته زمناً طويلاً، ثمّ قام برحلتين أخريين قطعتا عليه حبل التفكير والسكون، إلا أنّه عاد إلى أكاديميّته ليستأنف حياة التفكير والتعليم، ولم يكدّر صفوه في أخريات أيّامه إلا الإنقسام الّذي نشأ في مدرسته، والّذي يعدّ أرسطو مسؤولاً عنه، وبينما كان منهمكاً في الكتابة – أو في حفلة عرس حسب قول آخرين – صعدت روحه برفق وهدوء كأنّما أخذ بالعين إِغفاء.
-
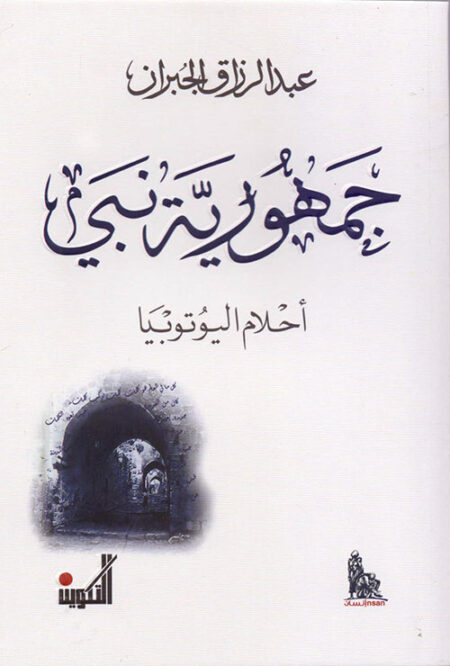
Alif Baa Alkitab Librairie Papeterie – El Khayati