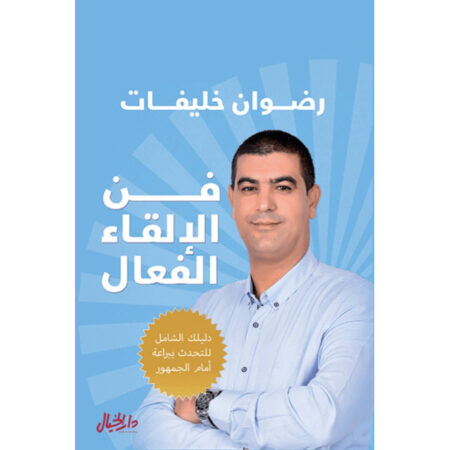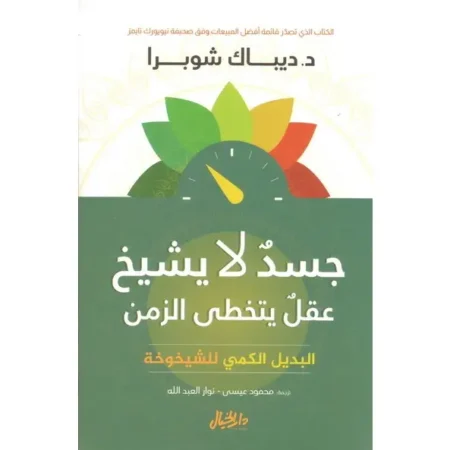-
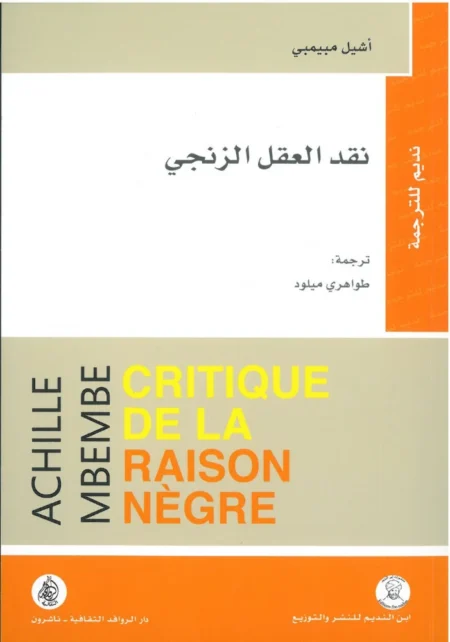
نقد العقل الزنجي
د.م. 120,00قد كان الزنجي الوحيد من بين كافة البشر الذي صير لحمه سلعة. زد الى ذلك ان الزنجي والعرق لم يكنا الا شيئا واحدا في مخيال المجتمعات الاوروبية حيث شكلا معا منذ القرن الثامن عشر قبوا غير معترف به وغالبا منكرا انتشر انطلاقا منه المشروع المعرفي الحديث – لكن ايضا مشروع الحكم – ذلك ما يجعلنا نتساءل عم اذا كان تراجع اوروبا الى مصاف مقاطعة بسيطة من هذا العالم وزوال العنصرية سيؤشر على تحلل احد دولها الكبرى الا وهو الزنجي؟ او بالعكس بعد ذوبان هذه الصورة التاريخية الن يتحول جميعنا الى زنوج العنصرية الجديدة التي تصنعها على مستوى الكوكبي السياسات الليبرالية الجديدة والامنية و حروب الاحتلال الجديدة والسلب وممارسات خلق المناطق؟
في هذه الباكورة التاليفية العليمة والمعادية للايقونات يبدأ اشيل مبيمبي تفكيرا نقديا لا مناص منه للاجابة على السؤال الرئيس حول عالمنا الحاضر: كيف يمكن النظر الى الاختلاف والحياة الى الشبيه وغير المتشابه.
اشيل مبيمبي استاذ التاريخ والعلوم السياسية وفيلسوف بجامعة فيفاترسراند في جوهانسبرج(افريقيا الجنوبية). ومنظر للفكر ما بعد الكولونيالي. وجمالا نقول ان اهتماماته الرئيسية تمثل في تاريخ افريقيا والسياسة الافريقية والعلوم الاجتماعية.
-
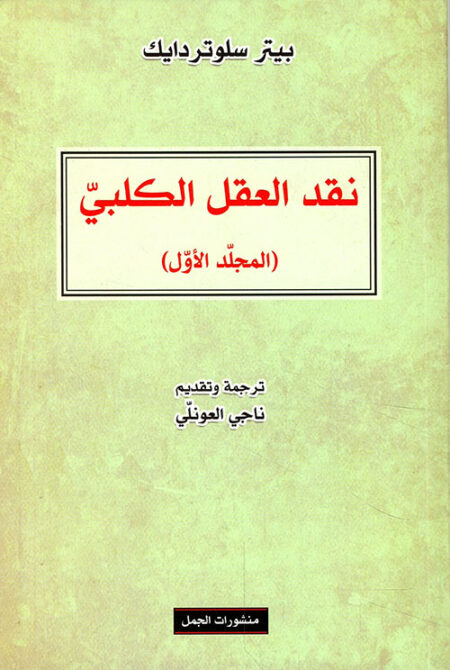
-
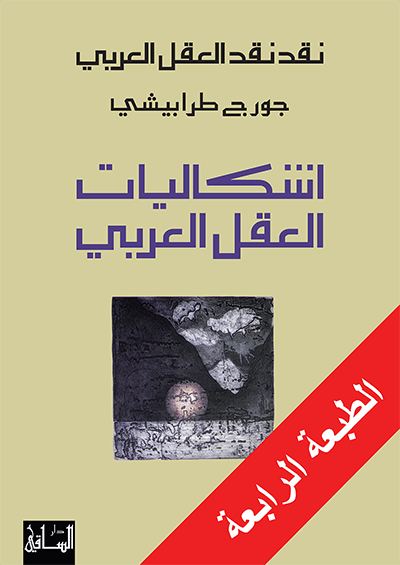
نقد نقد العقل العربي، إشكاليات العقل العربي
د.م. 140,00إذا كان المنهج التفكيري لمحمد عابد الجابري يقوم على صياغة إشكاليات مغلقة أشبه ما تكون بحبائس، فإن منهج طرابيشي في نقد النقد لا يسعى فقط إلى تفكيك الإشكاليات التي يأسر فيها الجابري قارئه، بل كذلك إلى اقتراح إشكاليات بديلة، مفتوحة وواعدة بفرح العقلانية بدلاً من ذلّ الدوغمائية.إشكالية الإطار المرجعي للعقل العربي: فبعد تفكيك أسطورة عصر التدوين كما يداورها الجابري قفزاً فوق مركزية الواقعة القرآنية، يعيد ناقده بناء إحداثيات هذه الواقعة كإطار مرجعي للعقل العربي وكنقطة مركز للدائرة الحضارية العربية الإسلامية.إشكالية اللغة والعقل: ورداً على اطروحة الجابري القائلة بأن العقل العربي مريضٌ بلغته، المتّهمة بأنها لغة “بدوية”، “حسّية”، “لاتاريخية” و”لاحضارية”، يعيد ناقده بناء الواقعة اللغوية العربية في تاريخيّتها وعقلانيّتها ونصابها الحضاري.إشكالية البنية اللاشعورية للعقل العربي: وضدّاً على القسمة الثلاثية العضال للنظام المعرفي للثقافة العربية الإسلامية إلى بيان وعرفان وبرهان، يفكّك طرابيشي مفهوم الجابري عن اللاشعور المعرفي ويكشف النقاب عن مديونيته الكاذبة لفوكو وليفي شتراوس وبياجيه.ما يحاوله هذا الجزء الثاني من “نقد نقد العقل العربي” هو رفع الحصار الذي تضربه الابستمولوجيا الجابرية حول هذا العقل. -

نقد نقد العقل العربي، نظرية العقل
د.م. 140,00نقد النقد ليس ظاهرة جديدة في الثقافة العربية الحديثة. فكتاب “في الشعر الجاهلي” لطه حسين استتبع نحواً من عشرين رداً، كذلك وجد من يردّ على “الإسلام وأصول الحكم” لعلي عبد الرازق بكتب كاملة. هذا التقليد هو ما يحاول جورج طرابيشي استئنافه في نقده “نقد العقل العربي” لمحمد عابد الجابري، ولكن من منظور مباين جذرياً. إن نقد النقد الذي يحاوله المؤلّف ليس دفاعياً. فمأخذه الأساسي على نقد الجابري كونه غير نقدي. والقراءة الجابرية للعقل العربي باتت تمثّل في نظره “عقبة ابستمولوجية” لأن الجابري قد أسر العقل العربي في إشكاليات مغلقة. وما لم تفكَّك هذه الإشكاليات، فإن أية مناقشة للنتائج والأحكام التي انتهى إليها مؤلف “تكوين العقل العربي” و”بنية العقل العربي” ستظلّ تدور كما لو على محور فارغ.من هذه الإشكاليّات المطلوب تفكيكها قبل محاولة استخلاص أجوبة جديدة: إشكالية “العقل المكوِّن والعقل المكوَّن”، وإشكالية “التفكير بالعقل والتفكير في العقل”، وإشكالية “العقلانية المغربية واللاعقلانية المشرقية”، وإشكالية “الهوية الضدية” للعقل العربي بالمقابلة مع العقل اليوناني القديم والعقل الغربي الحديث.“نظرية العقل” هو الجزء الأول في مشروع متعدّد الأجزاء لإعادة قراءة العقل العربي الإسلامي في فضائه الثقافي الخاص، وفي استمراريته ـ كما في قطعه ـ مع العقول الحضارية السابقة واللاحقة. -
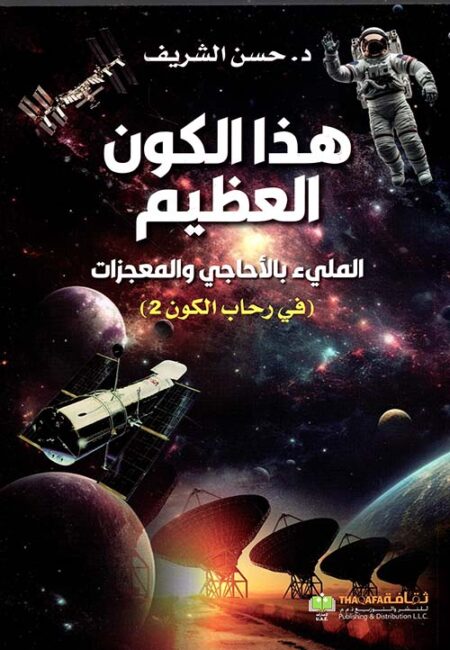
هذا الكون العظيم المليء بالأحاجي والمعجزات ( في رحاب الكون 2 )
د.م. 150,00هذا الكون العظيم المليئ بالأحاجي والمعجزات بقلم Hassan Al-Sharif … في رحاب الكون2″ كتاب مشوّق سهل القراءة وكبير الفائدة، يغطّي نقصاً في المكتبة العلمية العربية، وتتقصّى صفحاته قصة الأفلاك من الانفجار الأولي العظيم حتى ولادة الحياة على الأرض، وقصة التشكيلات الفلكية والأجرام المختلفة من المجرّات وتكتلاتها إلى النجوم وأصنافها وولادتها وموتها، إلى الكواكب وأنواعها، إلى دراسة احتمالية الحياة والحضارات خارج مجموعتنا الشمسية. في هذا الكتاب الرائد يتعمَّق الدكتور الشريف في دراسة نشوء النجوم والمجرّات والكواكب، استناداً إلى أحدث النظريات في الفيزياء الفلكية، والدراسات المستندة إلى بيانات التلسكوبات الأرضية والفضائية الدقيقة بغية نشر الثقافة العلمية ورفع مستوى الاهتمام العام بمعرفة الكون وروائعه، والتحدِّيات التي ما زالت تستثير عقول العلماء ومخيّلاتهم. -
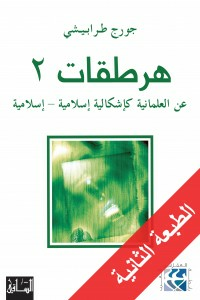
هرطقات 2 عن العلمانية كإشكالية إسلامية-إسلامية
د.م. 95,00غالباً ما تُصوَّر العلمانية في الأدبيات العربية السائدة على أنها إشكالية مسيحية – مسيحية جرى اختراعها في الغرب المسيحي حصراًلتسوية العلاقات بين طائفتيه الكبيرتين: الكاثوليكية والبروتستانتية، ولوضع حدّ بالتالي لما سمّي في أوروبا بحرب الأديان التي عصفت بها على امتداد أكثرمن مئة سنة.يؤكّد هذا الكتاب بعداً آخر للعلمانية كإشكالية إسلامية–إسلامية من خلال السجلّ المذهل الذي يقدّمه عن تاريخ الحرب، بالأفعال كما بالأقوال، التيدارت – ولا تزال – أكثر من ألف سنة بين كبريي طوائف الإسلام: السنّة والشيعة. ومن هذا المنظور تحديداً، يرى المؤلّف أن العلمانية تمثّل ضرورة داخلية ليتصالح الإسلام مع نفسه، وليستبدل ثقافة الكراهية بينطوائفه بثقافة المحبة، وليتحرّر في الوقت نفسه من أسر التسييس والأدلجة،وليستعيد، من خلال التعلمن، بُعده الروحي الذي هو مدخله الوحيد إلى الحداثة. -
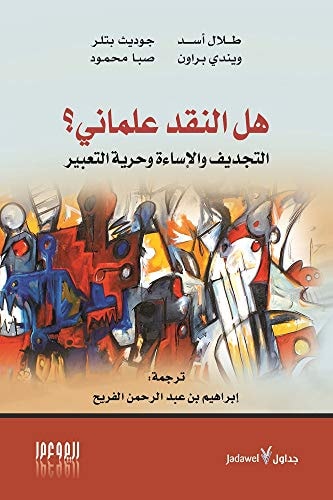
هل النقد علماني ؟ التجديف والإساءة وحرية التعبير
د.م. 90,00ما علاقة العلمانية بالنقد؟ هل النقد علماني بالضرورة؟ وهل العلمانية تستلزم النقد الذاتي بخلاف الرؤية الدينية المرتكزة على اليقين؟ وهل العلمانية تتسم بالموضوعية والعقلانية في حين يقابلها الدين القائم على الإيمان والاتباع؟ هل العلمانية محايدة بالنسبة للدين أو هي مُشكِّلة له؟ وكيف يمكن فهم حرية التعبير في ظل الدولة الحديثة ومن خلال الصراع القائم بين العلمانية والدين؟ كيف ساهمت العلمانية في تشكُّل هوية المجتمعات الغربية الحديثة وفي تشكيل نظرتها للعالم غير الغربي؟
هذه بعض الأسئلة المحورية التي يناقشها أربعة من أبرز المفكرين المعاصرين في هذا الكتاب، منطلقين من قضية الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام التي نشرتها صحيفة يولاند بوستن الدنماركية في عام 2005 وأثارت في حينها عاصفة من ردود الأفعال بين المسلمين الذين رأوا فيها تعديًا على نبيهم وإساءة له، قابلها في الغرب دعوات للدفاع عن حرية التعبير.يتداول هذا الكتاب جوانب من معنى العلمانية وحرية التعبير من خلال تطورهما التاريخي ومن خلال واقعهما اليوم، وكذلك مفهوم النقد وتحولاته، والعلاقة بين العالم الإسلامي والغرب، وبين الرؤية الدينية والعلمانية للعالم، ساعيًا لتفكيك هذه المصطلحات ومساءلة افتراضاتها وأطرها الفكرية.
-
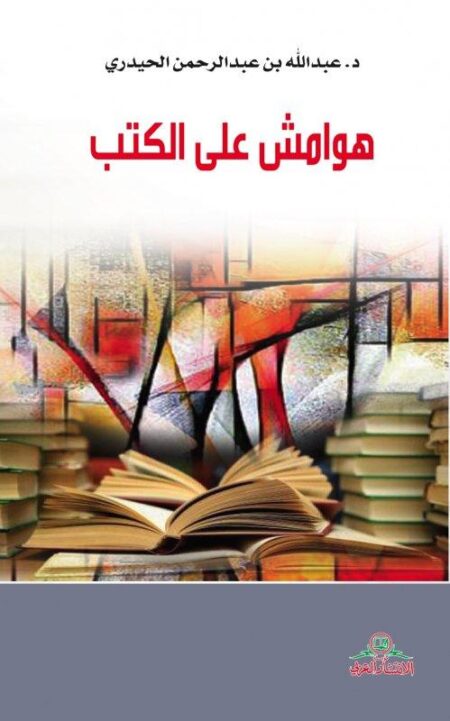
هوامش على الكتب
د.م. 50,00تُخصص كبريات الصحف والمجلات في العالم مساحات واسعة للكتب: تعريفاً وعرضاً ونقداً ومراجعة، وهي مما يُقبل عليه القراء بشغف؛ نظراً لأنها مواد مهمة تعرّف بالجديد من الكتب، وتلفت الانتباه إلى الإضافة فيها، وتنبه على ثغراتها إن وجدت. ومادة هذا الكتاب في الأصل، م -
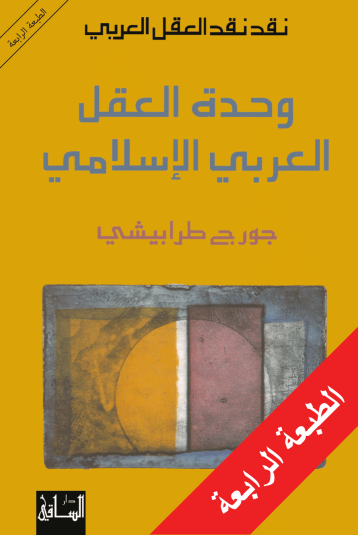
وحدة العقل العربي الإسلامي
د.م. 130,00يقوم كل مشروع محمد عابد الجابري في نقد العقل العربي، على اصطناع “قطيعة معرفية” بين فكر المشرق وفكر المغرب، وعلى التمييز بين “مدرسة مشرقية إشراقية ومدرسة مغربية برهانية”، وعلى التوكيد أن رواد “المشروع الثقافي الأندلسي ـ المغربي” ـ ابن حزم وابن طفيل وابن رشد وابن مضاء القرطبي والشاطبي ـ تحركوا جميعهم في اتجاه واحد هو “اتجاه رد بضاعة المشرق إلى المشرق”، و”الكف عن تقليد المشارقة”، و”تأسيس ثقافة أصيلة مستقلة عن ثقافة أهل المشرق”. هذا الجزء الثالث من مشروع طرابيشي لـ”نقد نقد العقل العربي” يتصدّى لتفكيك تلك “الإبستمولوجيا الجغرافية” من منطلق توكيد وحدة بنية العقل العربي الإسلامي، ووحدة النظام المعرفي الذي ينتمي إليه بجناحيه المشرقي والمغربي، ووحدة المركز الذي تفرّعت عنه دوائره المحيطة. فلا التحوّل من دائرة البيان إلى دائرة العرفان أو دائرة البرهان، يعني انعتاقاً من جاذبية نقطة المركز، ولا التنقل بين الخانات يمكن أن يكون خروجاً عن رقعة شطرنج العقل العربي الإسلامي الذي يبقى يصدر عن نظام إبتسمي واحد مهما تمايزت عبقريات الأشخاص وعبقريات الأماكن. هذا الكتاب، إذ يرفض التوظيف الأيديولوجي الإقليمي لمفهوم القطيعة الإبتسمولوجية، يتوسّل حفريات المعرفة الحديثة ليعيد بناء وحدة الفضاء العقلي للتراث العربي الإسلامي، وليقترح قراءة اتصالية – لا انقطاعية – للإسهامات المميزة للمدرسة الأندلسية، سواء أتمثلت في مقاصدية الشاطبي، أم عرفانية ابن طفيل، أم الانتفاضة النحوية لابن مضاء القرطبي. وهذا، بالإضافة إلى إعادة فتح ملف “الفلسفة المشرقية” لابن سينا واقتراح حل جديد للغزها.
Alif Baa Alkitab Librairie Papeterie – El Khayati