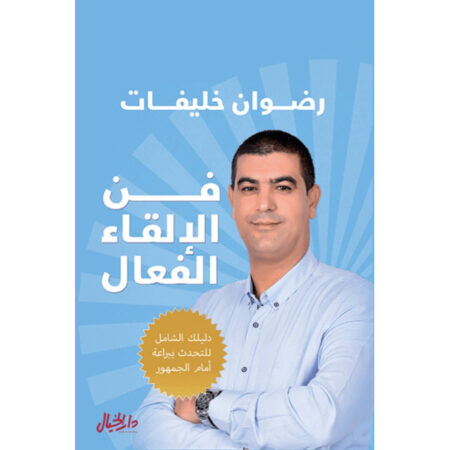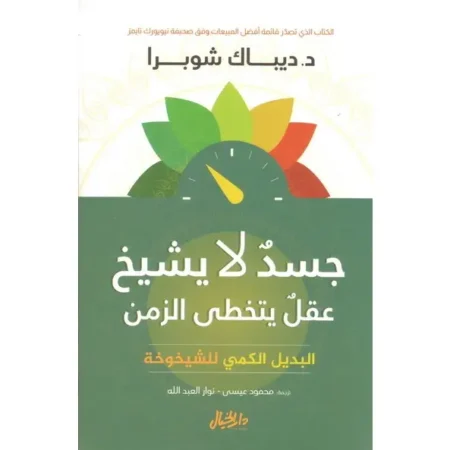-

مغزى القراءة
د.م. 70,00مغزى القراءة بقلم بيتر شتاينز … في مسرحية إلكريك،يُعلن موت البطل صاحب اللقب. سيضطر إلى تقديم كشف حساب إلى الله وهو قلق للغاية بشأن ذلك، لأنه.”للأسف هناك القليل فقط من الخير المدون في دفتر حسابات حياتي”. بالإضافة إلى ذلك، يرفض الجميع مرافقته؛ أصدقاؤه وعائلته وممتلكاته الأرضية. فيقرر اللجوء إلى الفضيلة، لكنه يجدها ضئيلة للغاية. عندما يسير نحو مصيره الأخير، لا يقف بجانبه سوى قيم الجمال والقوة والحكمة والحواس الخمس، لكنهم يتركونه عند فوهة القبر. وحدها الفضيلة والمعرفة الذاتية هي من يعود في اللحظة الأخيرة لتذهب معه إلى الآخرة.
-
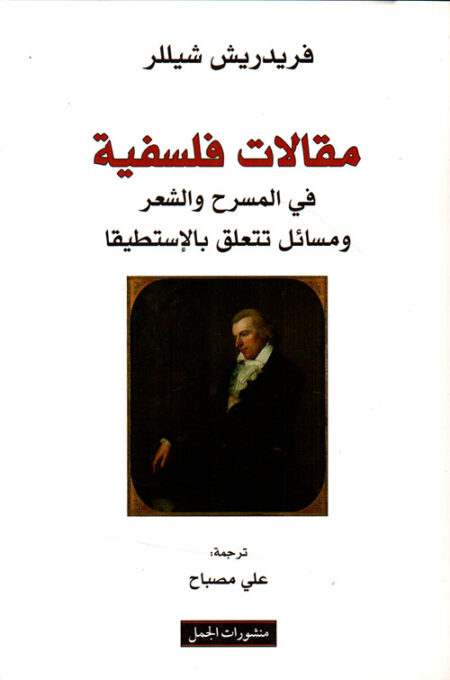
-
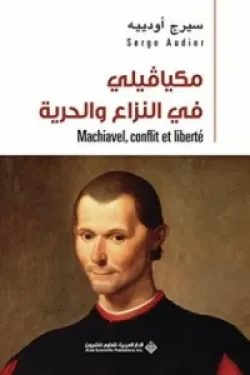
مكيافيلي في النزاع والحرية
د.م. 150,00مكيافيلي في النزاع والحرية بقلم سيرج أودييه … ثمة واقع لا جدال فيه؛ يمارس فكر ميكافيلي اليوم تأثيراً كبيراً في الفلسفة السياسية. ومن بين الأفكار المؤسسة في هذا المجال تثير أعمال الفيلسوف الفلورنساوي، بلا أدنى شك، مقاربات وقراءات متناقضة عديدة. فكل مرة، كان يعاد اكتشاف هذا الفكر بطريقة أخرى. تارة بنظرة تستنكر ما حوته من رؤية كَلبيّة للسلطة، وبنظرة الثناء تارة أخرى، لأنها رائدة في مجال علم السياسة. كما أن هناك من رأى في مكيافيلي إحدى الشخصيات البارزة المعبرة عن النزعة الجمهورية الحديثة. كتاب سيرج أودييه هذا، ليس كتاباً إضافياً – ولا، بخاصة، كتاباً زائداً – يُدرج على قائمة الدراسات اللامحدودة حول أعمال مكيافيلي. فما تميز به هي النيّة النقدية التي ينطوي عليها. وتقوم على أنه يقدم قراءة تركز على موضوعة المنازعات السياسية والاجتماعية وفاقاً للتفسيرات الرئيسة التي ظهرت في القرن العشرين، والتي كان رهانها التفكير حول العلاقة بين النزعة الجمهورية والنزعة الليبرالية تفكيراً مغايراً يولي أهمية أولى لدور الحرية فيها، الأمر الذي قاد المؤلف إلى اعتبار مكيافيلي منظّر “المذهب التعددي النزاعي” ويتيح، عن طريق نظريته في الأمزجة، التفكير حول ما يعود للـ “انقسامات” من دور في الحياة السياسية للمجتمعات الحديثة. ويستند في ذلك على أطروحته القائلة بأن القراءة الفرنسية التي ينضوي تحتها تدعو إلى التفكير حول الشروط التي يرتبط فيها النزاع مع التوافق، من منظور تحقيق مُثل النزعة الكونية المتعلقة بالحداثة الديمقراطية. ويبقى في النهاية السؤال مطروحاً أمام المختصين: كيف يمكن التفكير انطلاقاً من مكيافيلي، ولكن في ما يتجاوزه أيضاً، حول الحقيقة الفعلية للسياسة وتبعاتها من منظار صورة النزاع”
-

-
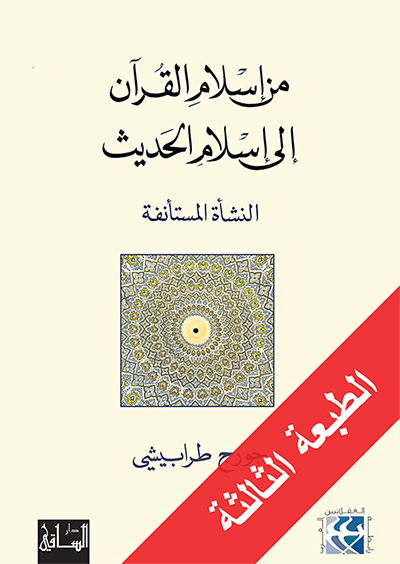
-
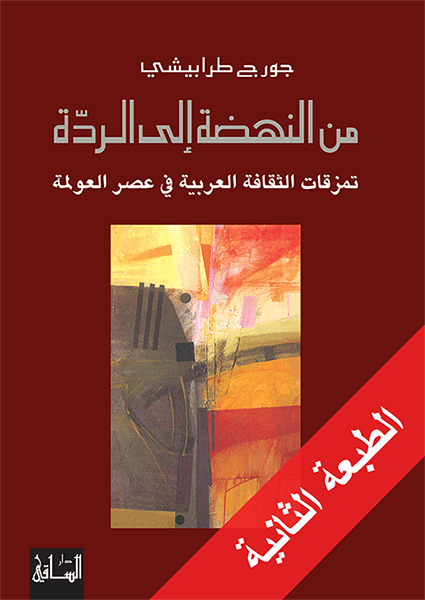
من النهضة إلى الردة تمزقات الثقافة العربية في عصر العولمة
د.م. 99,00هذا الكتاب مسكون بالهاجس النهضوي في زمن طغيان إرادة الردة.من محاور هذا الكتاب: الجرح النرجسي العربي، ثنائية المنافحة والنقد، ثقافة الكراهية، لاهوت نفي الآخر، المرض بالغرب، انطفاء الماركسية، رهاب العولمة، الإسلام والمسألة النسوية، الآخر في التراث العربي الإسلامي، البدعة والعقل المقتول، التراث وأسئلة الحداثة، الهوية والتماهي، الثقافة المنفتحة والثقافة المغلقة، الأسئلة الفلسفية المقموعة، التحديث والتغريب، جدلية الجذور والأجنحة.من حوارات هذا الكتاب: قاسم أمين، طه حسين، زكي الأرسوزي، ياسين الحافظ، نجيب محفوظ، محمد أركون، جلال أحمد أمين، وممثلون آخرون للأنتلجنسيا العربية. -
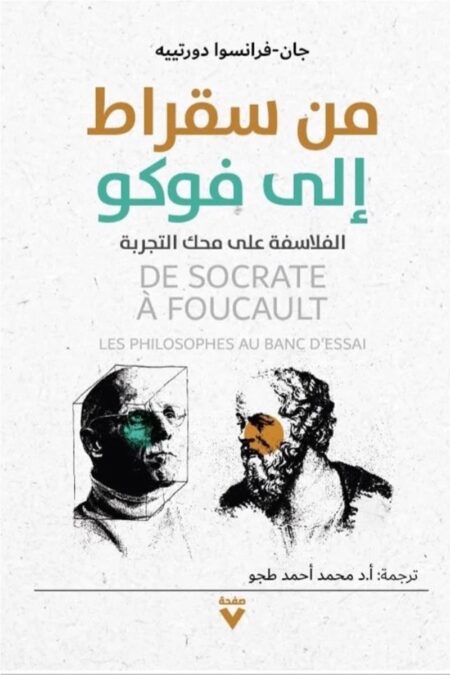
من سقراط إلى فوكو ؛ الفلاسفة على محك التجربة
د.م. 120,00ما الفلسفة حقا؟ هل نعيش بشكل أفضل حين نتوسل بها؟ هل يتطور تفكيرنا؟ وهل تمكننا من إدراك المعرفة والحقائق إدراكا أعلى كما يعتقد أفلاطون وسبينوزا أو هيجل؟ ألا تكون مجرد طريقة “لإدارة العقل بشكل جيد” (ديكارت)، أو لتوضيح أفكار المرء (فيتغنشتاين) أو حتى لإنشاء عِلْمٍ جديد للعقل (هوسرل)؟ ألا يمكن أن تتحول إلى آلة شيطانية، لا تُنتج أي معرفة، لأنها ببساطة تريد دائما التشكيك في كل شيء؟
يسعى هذا الكتاب إلى فهم المشروع الفلسفي وطبيعته وطموحاته، عبر تحقيق دقيق لخمس عشرة شخصية فلسفية عظيمة، من سقراط إلى ميشيل فوكو، محاولا الوقوف على المشروع التأسيسي الذي غذّى تفكير الجميع، وإعادته إلى زمانه وسيافه و«حدسه التأسيسي»، ولكن دون إخفاء مناطقه الرمادية وتناقضه وطرقه المسدودة. ومن هذه الزاوية فهو يطمح إلى وضع مناهج هؤلاء الفلاسفة وأدواتهم على «محك التجربة». فما الذي تجلبه لنا قراءة أفلاطون أو أرسطو أو كانط أو سبينوزا أو دريدا فعلا؟ وكيف كان مآل الفلسفة التحليلية والظواهر وفلسفة العلم بعد قرن من ظهورها؟
في هذا الكتاب، يُخرج جان فرانسوا دورتييه خمسة عشر وحشا مقدسًا من قفص الطمأنينة ويضعهم تحت مجهر العقل، وهو يطرح عليهم وعلى القارئ سؤالا محوريا: هل يجعلنا الفلاسفة حقا أكثر ذكاء؟
-
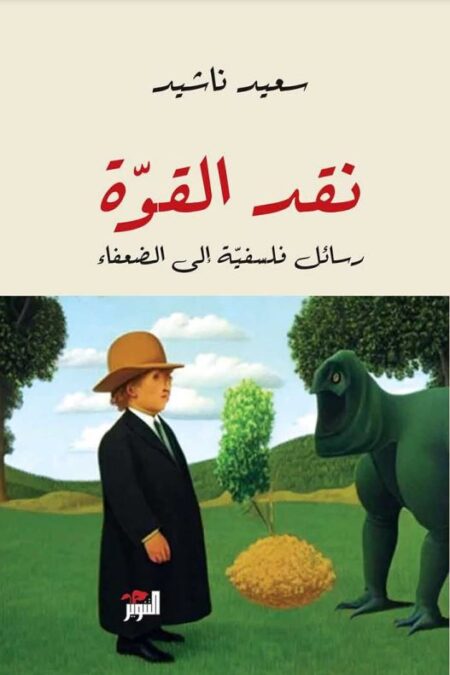
نقد القوة ؛ رسائل فلسفية إلى الضعفاء
د.م. 120,00يبدأ هذا الكتاب من مختلف المطلقات: إن الحب مهارة تحتاج إلى الأبد، ولا تخطئ في قلب الإنسان. ويأخذنا بهدوء وبأسلوب جذّاب لنتلمّس القضايا الأساسية في العلاقات، من الشجار إلى ممارسة الحب، من التسامح إلى التواصل، مؤكّدًا أن النجاح في الحب يجب ألا يترك الحظ بعد الآن
-

نقد نقد العقل العربي، نظرية العقل
د.م. 140,00نقد النقد ليس ظاهرة جديدة في الثقافة العربية الحديثة. فكتاب “في الشعر الجاهلي” لطه حسين استتبع نحواً من عشرين رداً، كذلك وجد من يردّ على “الإسلام وأصول الحكم” لعلي عبد الرازق بكتب كاملة. هذا التقليد هو ما يحاول جورج طرابيشي استئنافه في نقده “نقد العقل العربي” لمحمد عابد الجابري، ولكن من منظور مباين جذرياً. إن نقد النقد الذي يحاوله المؤلّف ليس دفاعياً. فمأخذه الأساسي على نقد الجابري كونه غير نقدي. والقراءة الجابرية للعقل العربي باتت تمثّل في نظره “عقبة ابستمولوجية” لأن الجابري قد أسر العقل العربي في إشكاليات مغلقة. وما لم تفكَّك هذه الإشكاليات، فإن أية مناقشة للنتائج والأحكام التي انتهى إليها مؤلف “تكوين العقل العربي” و”بنية العقل العربي” ستظلّ تدور كما لو على محور فارغ.من هذه الإشكاليّات المطلوب تفكيكها قبل محاولة استخلاص أجوبة جديدة: إشكالية “العقل المكوِّن والعقل المكوَّن”، وإشكالية “التفكير بالعقل والتفكير في العقل”، وإشكالية “العقلانية المغربية واللاعقلانية المشرقية”، وإشكالية “الهوية الضدية” للعقل العربي بالمقابلة مع العقل اليوناني القديم والعقل الغربي الحديث.“نظرية العقل” هو الجزء الأول في مشروع متعدّد الأجزاء لإعادة قراءة العقل العربي الإسلامي في فضائه الثقافي الخاص، وفي استمراريته ـ كما في قطعه ـ مع العقول الحضارية السابقة واللاحقة.
Alif Baa Alkitab Librairie Papeterie – El Khayati