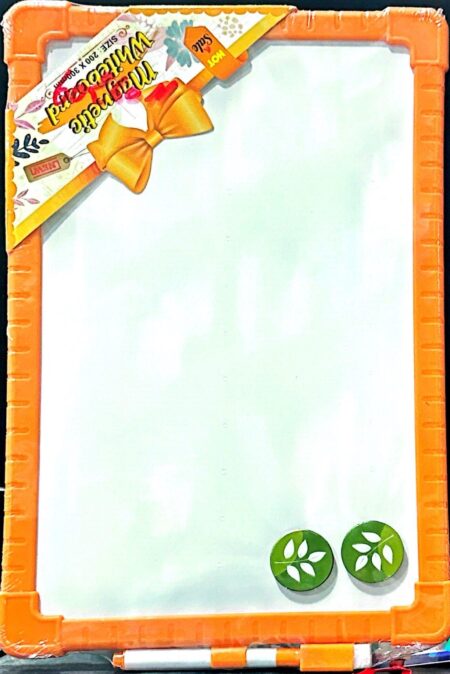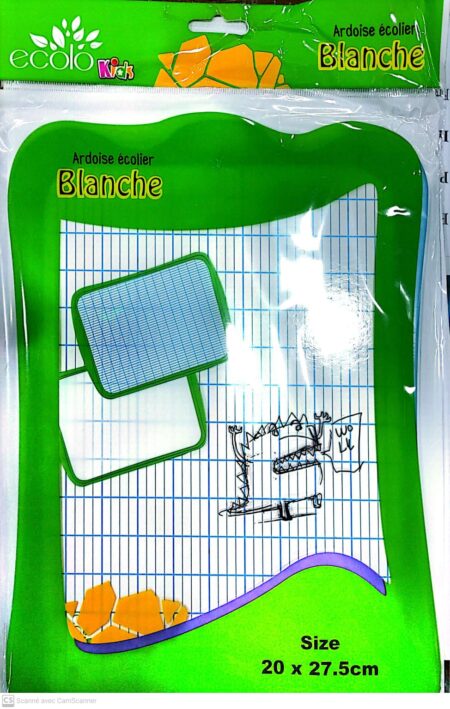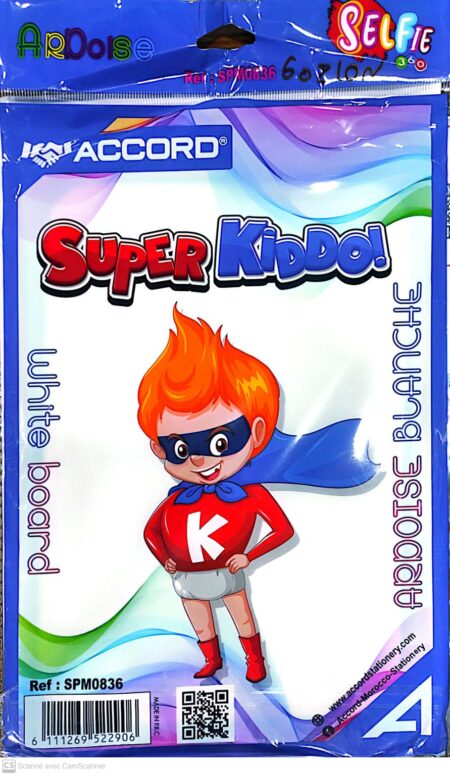-
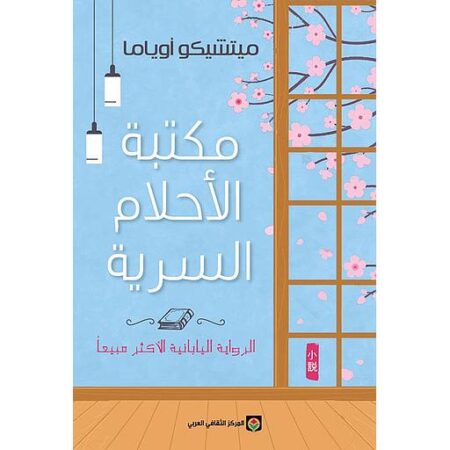
-
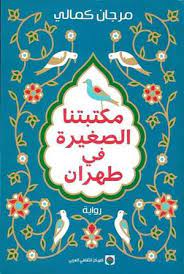
-
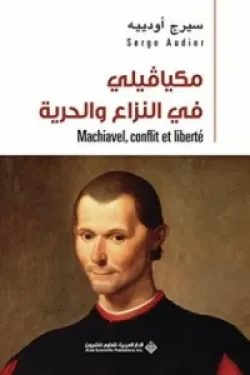
مكيافيلي في النزاع والحرية
د.م. 150,00مكيافيلي في النزاع والحرية بقلم سيرج أودييه … ثمة واقع لا جدال فيه؛ يمارس فكر ميكافيلي اليوم تأثيراً كبيراً في الفلسفة السياسية. ومن بين الأفكار المؤسسة في هذا المجال تثير أعمال الفيلسوف الفلورنساوي، بلا أدنى شك، مقاربات وقراءات متناقضة عديدة. فكل مرة، كان يعاد اكتشاف هذا الفكر بطريقة أخرى. تارة بنظرة تستنكر ما حوته من رؤية كَلبيّة للسلطة، وبنظرة الثناء تارة أخرى، لأنها رائدة في مجال علم السياسة. كما أن هناك من رأى في مكيافيلي إحدى الشخصيات البارزة المعبرة عن النزعة الجمهورية الحديثة. كتاب سيرج أودييه هذا، ليس كتاباً إضافياً – ولا، بخاصة، كتاباً زائداً – يُدرج على قائمة الدراسات اللامحدودة حول أعمال مكيافيلي. فما تميز به هي النيّة النقدية التي ينطوي عليها. وتقوم على أنه يقدم قراءة تركز على موضوعة المنازعات السياسية والاجتماعية وفاقاً للتفسيرات الرئيسة التي ظهرت في القرن العشرين، والتي كان رهانها التفكير حول العلاقة بين النزعة الجمهورية والنزعة الليبرالية تفكيراً مغايراً يولي أهمية أولى لدور الحرية فيها، الأمر الذي قاد المؤلف إلى اعتبار مكيافيلي منظّر “المذهب التعددي النزاعي” ويتيح، عن طريق نظريته في الأمزجة، التفكير حول ما يعود للـ “انقسامات” من دور في الحياة السياسية للمجتمعات الحديثة. ويستند في ذلك على أطروحته القائلة بأن القراءة الفرنسية التي ينضوي تحتها تدعو إلى التفكير حول الشروط التي يرتبط فيها النزاع مع التوافق، من منظور تحقيق مُثل النزعة الكونية المتعلقة بالحداثة الديمقراطية. ويبقى في النهاية السؤال مطروحاً أمام المختصين: كيف يمكن التفكير انطلاقاً من مكيافيلي، ولكن في ما يتجاوزه أيضاً، حول الحقيقة الفعلية للسياسة وتبعاتها من منظار صورة النزاع”
-
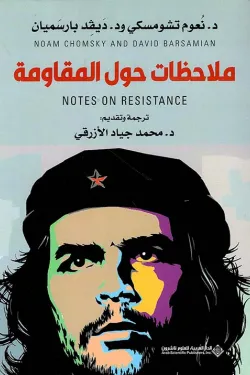
ملاحظات حول المقاومة
د.م. 160,00ملاحظات حول المقاومة بقلم نعوم تشومسكي … بين شرعية وجود مقاومة للشعوب، أياً كان موطنها، وبين عدم شرعيتها ورفضها، يقدم الكتاب تشخيصاً مختلفاً يعيد من خلاله – المفكر اليساري والناشط السياسي المعروف نُعوم تشومسكي ومحاوره الصحافي دايفيد بارسميان – المفهوم إلى نصابه العلمي الصحيح، ويكشف عما ينطوي عليه من إشكاليات عبر تسعة حوارات شيقة وغنية يطرح المحاور فيها الأسئلة التي ينبغي أن تُطرح، ويتولى المجيب الإجابة بعد أن يعيد تركيب المشهد العالمي خلال العقدين الأخيرين وعلى أكثر من صعيد. ليس هناك شك بأن ملاحظات تشومسكي حول المقاومة ستلهم كافة أولئك الذين يكافحون من أجل تحرير الإنسان أينما كان.
-

-
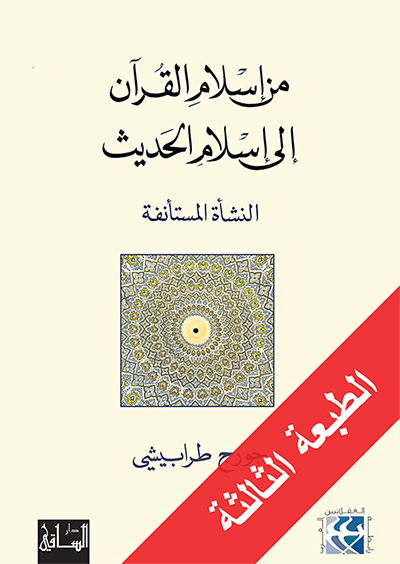
-
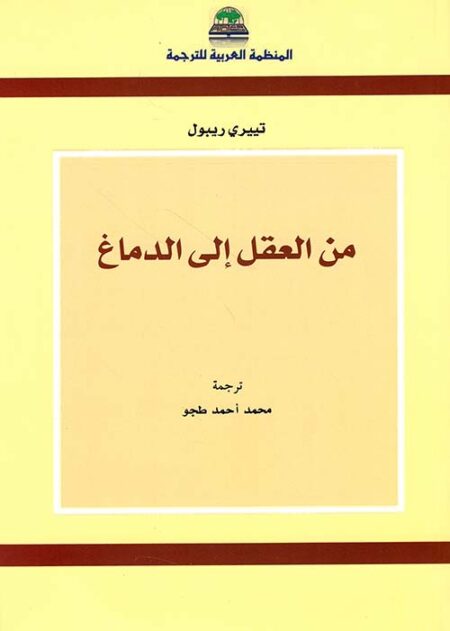
من العقل إلى الدماغ
د.م. 199,00تُقر جميع الثقافات بشكل عام أن عالمنا يتكون من كيانات مادية وغير مادية، والبشر الذين يشاركون في هذا العالم ليسوا استثناء لقاعدة هذا التكوين المزدوج… لأنّ لهم جسداً وروحاً.
يقوم مفهوم الإنسان هذا، وهو وريث تقليدٍ فلسفيّ طويل، بدورٍ مهم في إدراكنا للحياة أو المجتمع أو الإرادة الحرة أو المعاناة النفسية، ويشمل ذلك الذين يقولون إنهم ملحدون أو لا أدريون. ومع ذلك جدّدت ثورة العلوم المعرفية التي شارك فيها علم النفس والعلوم العصبية والذكاء الاصطناعي والفلسفة تجديداً تاماً هذا المفهوم للعلاقة بين العقل والدماغ، وبيّنت أن هذه الثنوية غير موجودة، وأننا لسنا سوى نتيجة نشاطٍ معقد تقوم به مليارات العصبونات.
يحاول تييري ريبول في هذا الكتاب أن يقدّم أكبر عدد من الأدوات لفهم الاضطرابات الفلسفية الناجمة عن علوم العقل، والجدل المعاصر المثير للعاطفة، والاهتمام الذي يترتب على ذلك.
-
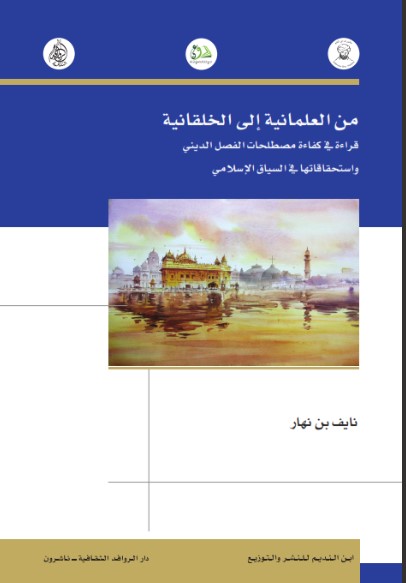
من العلمانية إلى الخلقانية ؛ قراءة في كفاءة مصطلحات الفصل الديني واستحقاقاتها في السياق الإسلامي
د.م. 120,00العلمانية تقوم على ثنائية السلطتين الكنسية والزمنية، ولأنَّ العالم بعد الثورة الفرنسية بدأ رسميًا بفصل السلطتين الزمنية والكنسية حتى لم يعد اليوم هناك أي دولة في العالم تكافح في سبيل الفصل بينهما، فإن مصطلح العلمانية يجب أن ينتهي بانتهاء معطياته، ويصبح جزءًا من التاريخ، فالصراع اليوم لم يعد بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية، وإنما الصراع اليوم بين الإنسان والدين نفسه. فإذا كان صراع السلطة قبل الثورة الفرنسية يقوم على ثنائية العلماني والثيوقراطي، فالصراع اليوم يقوم على ثنائية المتشرّع والخلقاني؛ أي الذي يؤمن بمرجعية الشرع والذي يرفض مرجعية الشرع ويرى مرجعية الخلق بديلاً عنها. وهذا التحوّل في الصراع كان أذانًا في الناس بدخول مرحلة “ما بعد العلمانية”، فأصبحت العلمانية بذلك تعبيرًا عن مرحلة تاريخية انتهت بكل معطياتها، وأصبحنا في مرحلة جديدة يكون طرف الصراع فيها الدين نفسه. واختلاف “أطراف” الصراع يقتضي اختلاف “عنوان” الصراع، ولذلك نقول إنه لا يوجد مسوّغ منطقي لاستعمال مصطلح العلمانية اليوم بعد أن غابت شروطه الموضوعية، وأمسى متعيّنًا أن يحل محله مصطلح “الخلقانية” الذي يعني حرفيًا المطالبة بحصر التشريع في الخلق دون الخالق.
-
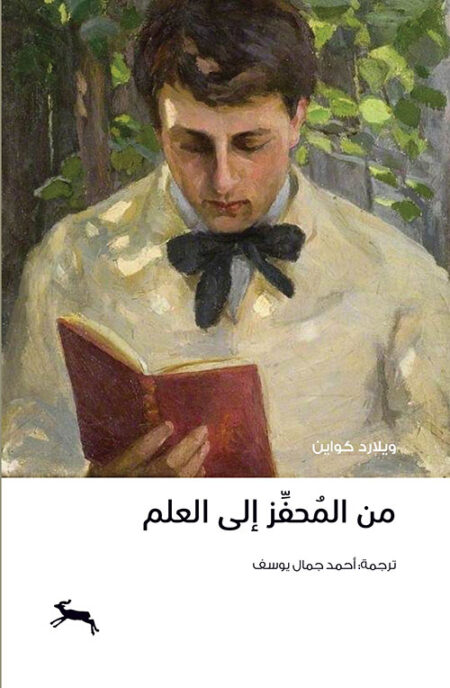
من المحفز إلى العلم
د.م. 119,00ويلارد فان كواين هو أحد أبرز الفلاسفة في القرن العشرين. أصدر كتابًا عميقًا وثريًا يلخص مشروعه الفلسفي بأكمله، بما في ذلك رؤيته لجميع المكونات الأساس لموقفه المعرفي؛ خاصة فيما يتعلق بقيمة المنطق والرياضيات. قد يتعين على القراء الذين يتعرفون على كواين لأول مرة عبر هذا الكتاب أن يقرؤوه ببطء وتأنٍّ، وأن يحاولوا أن يروا بأنفسهم ذلك الثراء والعمق الذي يعرفه عنه القراء السابقون ويكمن بين سطور هذا الكتاب الشيق.أصل هذا الكتاب صغير الحجم محاضرات ألقاها كواين في إسبانيا عام 1990، وفيها شرع كواين بموضعة إسهاماته في سياقها التاريخي. يقدم الكتاب جولة خاطفة في تاريخ الفلسفة (لا سيما تاريخ نظرية المعرفة)، بدءًا من أفلاطون، ثم يصل ذروته المعرفية في رسم مخطط تقديري لمستهدفات كارناب الفلسفية وإنجازاته. يصل هذا بنا إلى الفصل الثاني، الذي يعد مقدمة لمحاولة كواين تطبيع نظرية المعرفة، وهو ما يؤكد سيره على خطى كارناب وتركيزه على المشترك بينهما عوضاً عن الاختلافات. ثم تقوم الفصول التالية بتطوير السرد الطبيعاني لتطور العلم آخذة في الاعتبار إلى أي مدى تحسنت أجهزتنا المفاهيمية حتى نتمكن من رؤية العالم باعتباره يحوي أشياء يمكن إعادة تعريفها. ثم بعد أن أوضَح دور جمل الملاحظة في توفير نقاط الفحص اللازمة لتقييم النظريات العلمية، وبعد أن يئس من بناء معيار تجريبي لتحديد الجمل ذات الدلالة، يتناول كواين في الفصول المتبقية مجموعة متنوعة من القضايا المهمة حول المعرفة، ويختتم بمعالجة موسعة لآرائه في الإحالة والمعنى ومواقفه تجاه المفاهيم النفسية والوسيطة.
Alif Baa Alkitab Librairie Papeterie – El Khayati