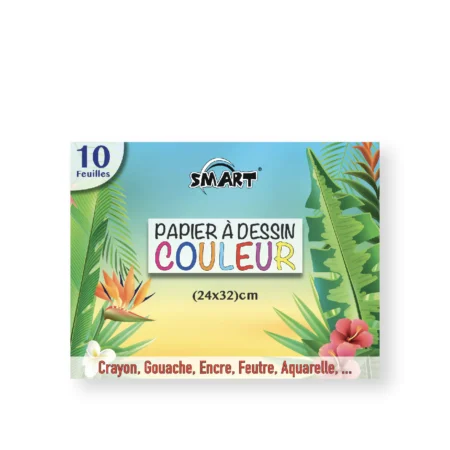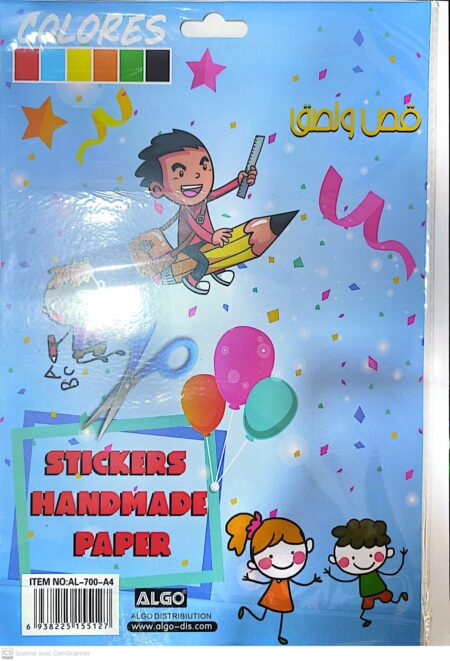-

النظام الشمولي آليات التحكم في السلطة والمجتمع
د.م. 150,00عملت حنّه آرنت منذ أن حطت الرحال في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الخمسينيات من القرن العشرين على مواصلة بحوثها في الفلسفة السياسية. فكان من بين دروسها أن كتبت ثلاثية متكاملة المشارب، حللت فيها أبعاد الحياة السياسية المعاصرة فلسفيًا، فكانت بذلك سبّاقة في عدّة مجالات لم يقع التطرّق إليها من قبل. وتناولت هذه الثلاثية على التوالي أوّلاً “الإمبريالية” بأشكالها القديمة والحديثة وحتى المعاصرة إلى حدود الحرب العالمية الثانية، ثمّ كرّست الثاني للحديث عن “المعادة للسامية”. وهو موضوع تناوله العديد من قبلها من وجهة نظر تاريخية فقط مثل بيار – فيدال ناكي وليون بولياكوف الذي رأي في تأليفه من جزأين “تاريخ المعاداة للسامية” بأنّ هذا الشعور، خاصة ضدّ اليهود، متأصل لدى البشرية. غير أنّ حنّه آرنت تناولت الموضوع من الناحية الفلسفية الدينية، من جذورها لكي تخلص إلى ما وصلت إليه النازية بحلها “النهائي” للقضاء على اليهود، متغافلة عن دور الصهيونية في تأجيج المشاعر خدمة لمشروعها. وربّما يعود هذا إلى أنّ حنّه آرنت، عندما قامت بدراسة هذه الظاهرة، في الخمسينيات من القرن الماضي، كانت الصهيونية تعتبر آنذاك في المحافل الدولية والأوساط السياسية والأكاديمية الأمريكية كحركة تحرّر من حصيلة الهولوكوست، أي أبستمولوجيا “القربان”. أمّا الجزء الثالث من هذه الثلاثية، فقد تناولت فيه حنّه آرنت “المنظومة الشمولية”، وهو محلّ هذه الترجمة. لقد حاولت حنّه آرنت في هذا التأليف اتباع تمشي علم السياسة الكلاسيكي، انطلاقًا من أرسطو إلى توكفيل مرورًا بغيرهما مثل ماكيافيل ومونتسكيو، قصد تحديد جوهر هذه المنظومة التي اعتبرتها غير مسبوقة وغير معروفة، ألا وهي ” المنظومة الشمولية
-
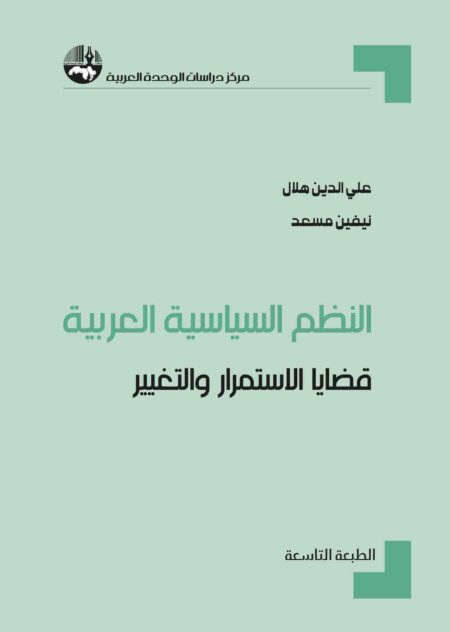
النظم السياسية العربية قضايا الاستمرار و التغير
د.م. 120,00يحاول هذا الكتاب التعريف بأهم خصائص النُظُم السياسية العربية، كجزء من مجموعة الدول النامية وكمجموعة متمايزة في حدّ ذاتها. ويتناول في هذا السياق القضايا التي تتعلق بالتطور الديمقراطي، والتنمية الاقتصادية، والتكامل القومي، والاستقلال السياسي، بعضها قضايا تنطوي على جوانب عامة مشتركة بين عموم الدول التي تمر بالمرحلة نفسها من مراحل التطور السياسي التي تعرف بالمرحلة الانتقالية. ولكن في الوقت نفسه، يشير التحليل إلى أنه بالتطبيق على المنطقة العربية، تجد هذه القضايا ما يميزها، بالنظر إلى الظروف المميزة للمنطقة على مستوى الخبرة التاريخية، وثقافتها السياسية، وعلاقاتها الإقليمية والدولية.
وبقدر ما تعبر خصائص النُظُم السياسية العربية عن مزيج بين ما هو عام وما هو خاص تجمع بين عناصر الاستمرار وعناصر التغيير. بمعنى أنه مع الإقرار بأن النُظُم العربية تختلف اختلافاً كبيراً عنها في اللحظة التي حصلت فيها على استقلالها، إلا أنها ما زالت تحمل معها الكثير من سمات هذه الخطة، فقضايا الخلافة السياسية، والهوية والحركات الإسلامية هي نماذج لهذه القضايا المستمرة التي تدخل بها النُظُم العربية الألفية الثالثة، والتي تميز تطورها في حدود الأمد المنظور.
يتضمن الكتاب فصلين، فضلاً عن المقدمة والخاتمة والمراجع. -
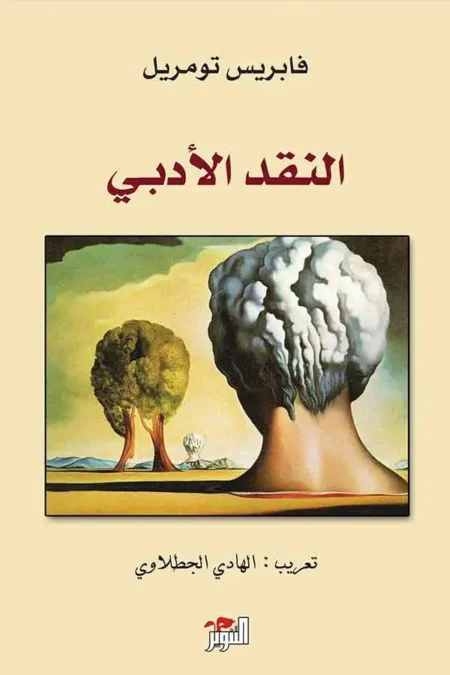
النقد الأدبي
د.م. 120,00v
يستعرض هذا الكتاب مختلف وجوه المقاربة، ويقدم الأمثلة التّي تمكّن الطلبة من التعوّد على أصناف النقد الكبرى (التقعيديّة والجماليّة والتفسيريّة) وعلى القضايا الكبرى (العلاقات بين النقد والعلم وبين النقد والأدب).. وعلى الاتّجاهات المنهجيّة الرئيسيّة (أصناف النقد الموسوعيّة والهرمينوطيقيّة والشّكليّة). وقد أولى هذا العمل التأليفيّ اهتماما خاصاً لأسلوب الناقد وخصائص مختلف أصناف الخطاب (الجامعي والصحافيّ والجمالي) وسوسيولوجيّة الحقل الأدبيّ، وأعمال «كريستيفا» و«ريكور» الأخيرة الخ..
وفيه كشف لمختلف أصناف النقد وما حصل فيها من التطوّر بالتركيز على النصف الثاني من القرن العشرين. ويسترعي عناية المختصّين في الأدب لأنّه بحث في تاريخ الأفكار وفي الأدب وفي المجتمع.
ويتضمن الكتاب بعض التحاليل والممارسات النقديّة ذات البعد التعليمي الذي يجسّد، تطبيقيّا، مناهج أو مبادئ أو مفاهيم سبق تقديمها تقديماً نظريا قد يبقى عند القارئ غائما من دون الأمثلة التطبيقيّة لتوضيحه وتجسيده. ووضعنا في آخر كلّ فصل ملخّصاً لأهمّ معانيه واختبار لمدى استيعاب مسائله.
ونظرا إلى طبيعة الكتاب العلميّة فقد حرصنا في تعريب هذا الكتاب على توخّي التأنّي في العمل والوفاء بالمعنى في أدقّ جزئيّاته مراعين في أداء المعنى روح التركيب العربي وخصائص الجملة العربية. ووضعنا قاموسا خاصّا بالمصطلحات وحاولنا أن نحدّد لها دلالتها الاصطلاحيّة لا فيما حملته في المطلق أو في غير هذا المصنّف ولكن كما حملته في سياقها الاصطلاحي في هذا الكتاب. -
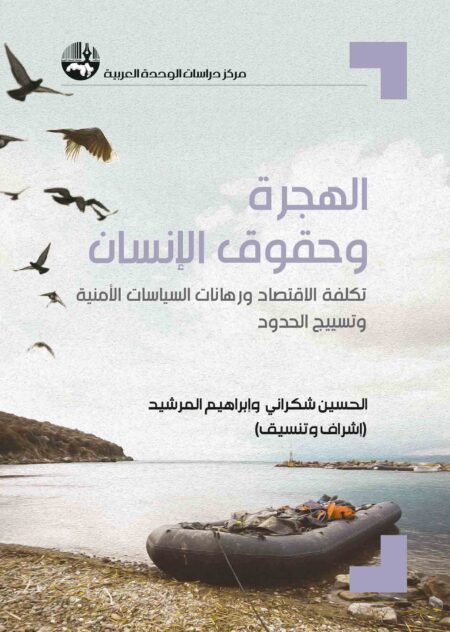
الهجرة وحقوق الإنسان : تكلفة الاقتصاد ورهانات السياسات الأمنية وتسييج الحدود
د.م. 140,00بين الاندماج تارةً والرّفض تارةً أخرى؛ وفي خِضم تَسَارُع ديناميات العولمة، التي تدفع باتجاه رفع القُيود وفتح الحدود وتجاوز الحواجز والأسوار والسياجات والانفتاح على الآخر من جهة أولى، أو باتجاه إغلاق الحدود في وجه الهجرة من جهة أخرى؛ تختلف سياسات الدول واستراتيجياتها بحسب مصالحها السياسية ورُؤَاهَا للمخاوف النّاجمة عن الهجرة. كما أن تكلفة تدبير الهجرة في إطار ملفات حقوق الإنسان وسياقاتها الاجتماعية والظّروف المحيطة بها تستلزم بلورة مبادرات تستوعب التنوع والاختلاف بين الثقافات، علاوة على توفير ميزانيات ضخمة للتّصدي لآثار الهجرة وأبعادها.
يعالج هذا الكتاب الإشكاليات التي تثيرها تداخلات الهجرة وحقوق الإنسان من منظورات الاقتصاد والسياسة والقانون وعلم الاجتماع والجغرافيا. فمن خلال تصفُّح الدّراسات المُقدمة في هذا المُؤلّف سنجد أنها تُقدم، من زاوية تقاطع الحقول المعرفية، معلومات غنية وأفكارًا مُفيدة ومناقشات محيّنة عن أسئلة معلّقة في ذِهن الباحث وصَانِع القرار السياسي حول التغيرات في المناخ والهوية والثقافة والاندماج وتنوع أبعادها؛ والأوضاع المعيشية للسكان في الوَاحَات والمناطق الجبلية التي أفرغت من سَاكنتها.
واعتماداً على الإشكاليات المرتبطة بالهجرة وحقوق الإنسان وتسييج الحدود (القومية)، يقدِّم هذا الكتاب مجموعة دراسات متنوعة ومتعددة حقول المعرفة الاجتماعية التي تسعى للإجابة عن الإشكالات الكبرى المطروحة في سياق ثُنائية العولمة – الحمائية، والأنا – الآخر؛ وإبراز تجلّيات ذلك على بعض البلدان العربية؛ مع التأكيد أن العالم يحتاج إلى تعزيز القيم المشتركة للانخراط على نحوٍ أفضل في عالم التّمايزات الثقافية والهوياتية.
-
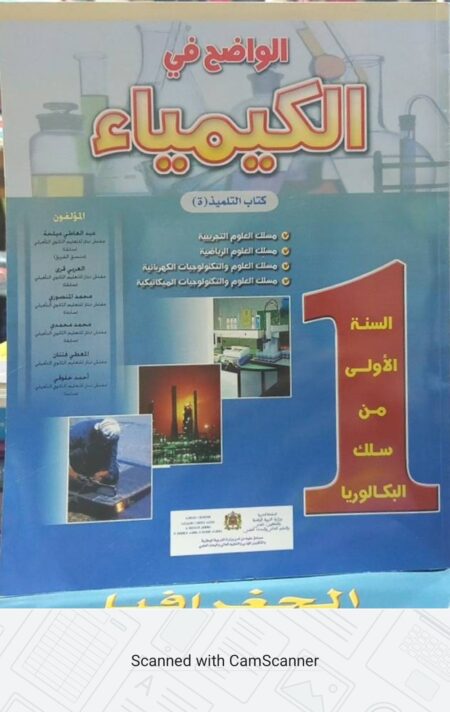
-
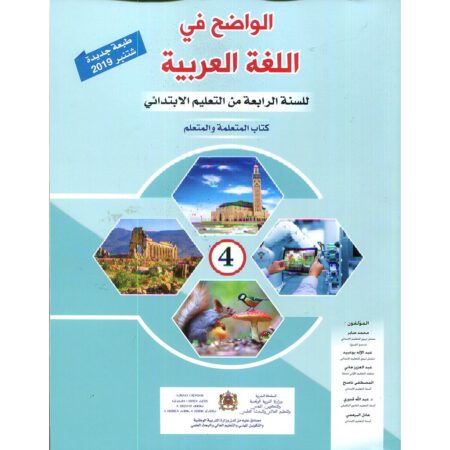
-

-
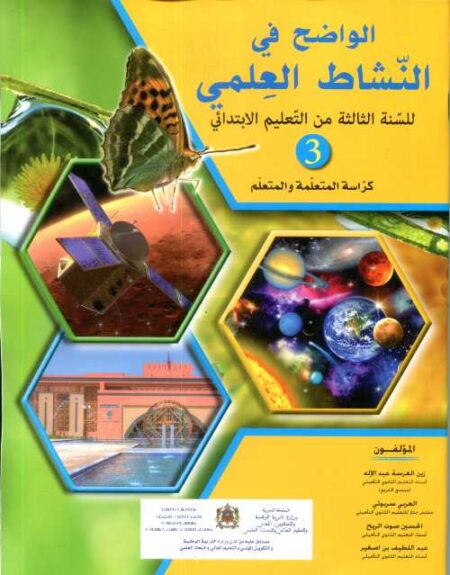
-
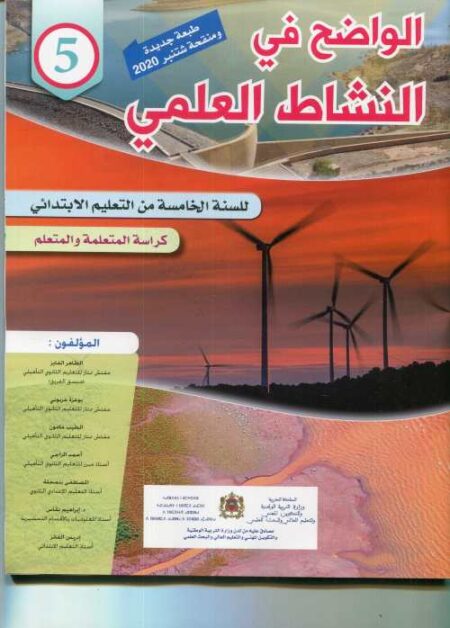
Alif Baa Alkitab Librairie Papeterie – El Khayati